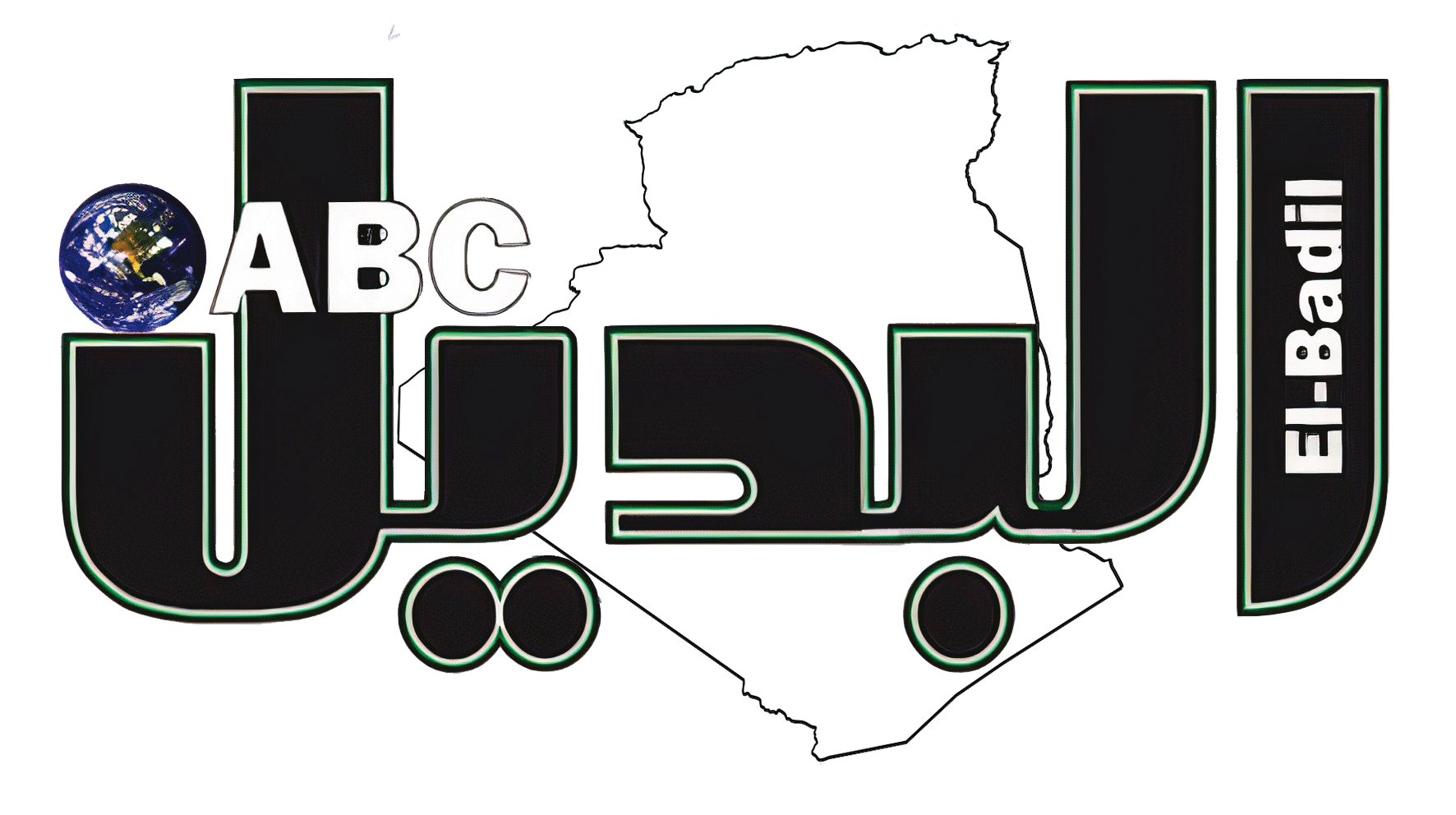منذ مطلع الألفية الجديدة، لم يعد الهاتف المحمول مجرد وسيلة للاتصال، بل تحوّل إلى واجهة للانخراط في الاقتصاد الرقمي العالمي، ولكن ما يُقدّم للمستهلك كأداة “ذكية” لتسهيل الحياة، ليس إلا منتجًا موجّهًا بعناية داخل نظام استهلاكي مُحكم.
الشركات الكبرى لا تبيع هواتف فحسب، بل تبيع رغبة مصمّمة مسبقا، تُزرع في لاوعي المستهلك من خلال الإعلانات والرموز والصور، وتُحاكي تطلعه الدائم نحو “الأفضل”، دون أن تعني الأفضلية بالضرورة تحسنا حقيقيا في الأداء أو جودة الحياة.
العطل المخطط
بعيدا عن النظرة التقنية المحضة، يُعدّ “التقادم المخطّط” أحد أخطر أدوات تسليع التكنولوجيا. فالهاتف الجديد الذي يشتريه الفرد اليوم، غالبًا ما سيبدأ في التباطؤ خلال عام أو عامين، إما عبر تحديثات برمجية مُرهقة أو عبر تغيّر البنية التحتية للتطبيقات، ما يدفع المستخدم إلى الشعور بأن هاتفه “صار قديمًا” رغم أنه لا يزال صالحًا. بهذا المعنى، لا تُقاس جدوى الهاتف بعمره الحقيقي، بل بعمره التسويقي الذي تحدّده الشركات المصنعة، في لعبة متقنة تحوّل الأدوات إلى نفايات قابلة للتبديل.
الدورة الاقتصادية للهاتف
تبدأ دورة حياة الهاتف في مصانع الشرق، غالبًا في بيئات عمل شديدة القسوة، وتصل إلى أيدي المستهلكين في الغرب أو في الأسواق النامية بواجهات أنيقة وأسعار باهظة. وما إن يُعلن عن إصدار جديد، حتى تبدأ الأجهزة “السابقة” في التقهقر نحو السوق الثانوية أو نحو القمامة الإلكترونية. ووفق تقارير بيئية، فإن أكثر من 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية تُنتج سنويًا، تشكّل الهواتف المحمولة جزءً كبيرًا منها. هذه الدورة لا تعني فقط استنزاف الموارد، بل تعني أيضًا استنزاف الإنسان بوصفه مستهلكًا وهدفًا دائمًا للعرض.
التقنية تحت هيمنة الشركات: من الابتكار إلى السيطرة
لطالما ارتبطت التكنولوجيا بفكرة التقدم، لكن واقع السوق يكشف وجهًا آخر: ليس الابتكار هو الهدف، بل الهيمنة. الشركات المنتجة لا تسعى دائمًا إلى تقديم الأفضل، بل إلى إبقاء المستخدم داخل نظام مغلق من الاعتماد، حيث لا يمكن تبديل البطارية بسهولة، ولا إصلاح الشاشة دون تكلفة باهظة، ولا استخدام الشاحن القديم مع الهاتف الجديد. إنها بيئة احتكارية تُبقي المستخدم محتجزًا ضمن دائرة الاستهلاك، خاضعًا لاختيارات الشركات لا لاحتياجاته الواقعية.
المستخدم بين التحديث القسري والحرية المقيدة
في كل مرة يُصدر فيها تحديث جديد لنظام التشغيل، يجد المستخدم نفسه مضطرًا للامتثال، حتى لو كان ذلك يعني إبطاء الجهاز أو تعطيل بعض خصائصه. وقد تكون التطبيقات الحديثة غير متوافقة مع الأجهزة القديمة، ما يعني أن البقاء ضمن المنظومة الرقمية يتطلب دائمًا اقتناء الأحدث. هذا الشكل من “التحديث القسري” يفرغ مفهوم الحرية التقنية من محتواه، ويحوّل الاستخدام إلى طاعة اقتصادية مدفوعة بالخوف من التخلف، لا بالرغبة في التحسين.
الوجه النفسي للاستنزاف
لا تنحصر آثار هذا النظام في الجوانب المادية فقط، بل تمتد إلى بُعد نفسي عميق. فالمستخدم الذي يلاحق دائمًا أحدث إصدار، يعيش في وهمٍ دائم بالامتلاك والتفوّق، لكنه لا يصل إلى حالة من الاكتمال أو الرضا. سرعان ما يصبح الهاتف الجديد “عاديا”، وتبدأ دورة التطلّع نحو الهاتف التالي. في هذه الدوامة، يصبح الإشباع مستحيلًا، ويُختزل الإنسان في رغبته الاستهلاكية، خاضعًا لإملاءات سوق لا يكفّ عن إعادة تعريف “ما يجب امتلاكه”.
البديل الغائب
لا يمكن الاكتفاء بانتقاد النظام الاستهلاكي دون طرح بدائل. فالسؤال الأساسي هو: هل نحتاج فعلا إلى هاتف جديد كل عام؟ أم أن الثقافة الرقمية قد شوّهت إدراكنا للاحتياجات الحقيقية؟ إن استهلاك التكنولوجيا ينبغي أن يكون عقلانيًا لا انفعاليًا، قائمًا على الفائدة والضرورة، لا على الصورة والمكانة الاجتماعية. ومع تنامي الوعي البيئي والاقتصادي، تظهر اليوم مبادرات إصلاح الهواتف، وإطالة عمرها، واعتماد البرمجيات الحرة كوسيلة للتحرر من قبضة الشركات الكبرى.
الهاتف كمرآة لاقتصادنا وثقافتنا
الهاتف ليس جهازًا فقط، بل مرآة تُظهر بنية الاقتصاد المعولم، وقيم المجتمع المعاصر، وحدود الحرية داخل نظام استهلاكي محكوم بالعرض. إنه كائن تقني يُدار ضمن منطق الربح لا منطق الحاجة، يُباع لنا بوصفه أداة للحرية، لكنه يُستخدم لتوجيه اختياراتنا وتحديد أولوياتنا. وبين الرغبة في التحديث والخوف من التخلّف، يبقى السؤال الجوهري معلقًا: من يملك القرار فعلًا؟ نحن، أم النظام الذي صمّم هذا السباق؟