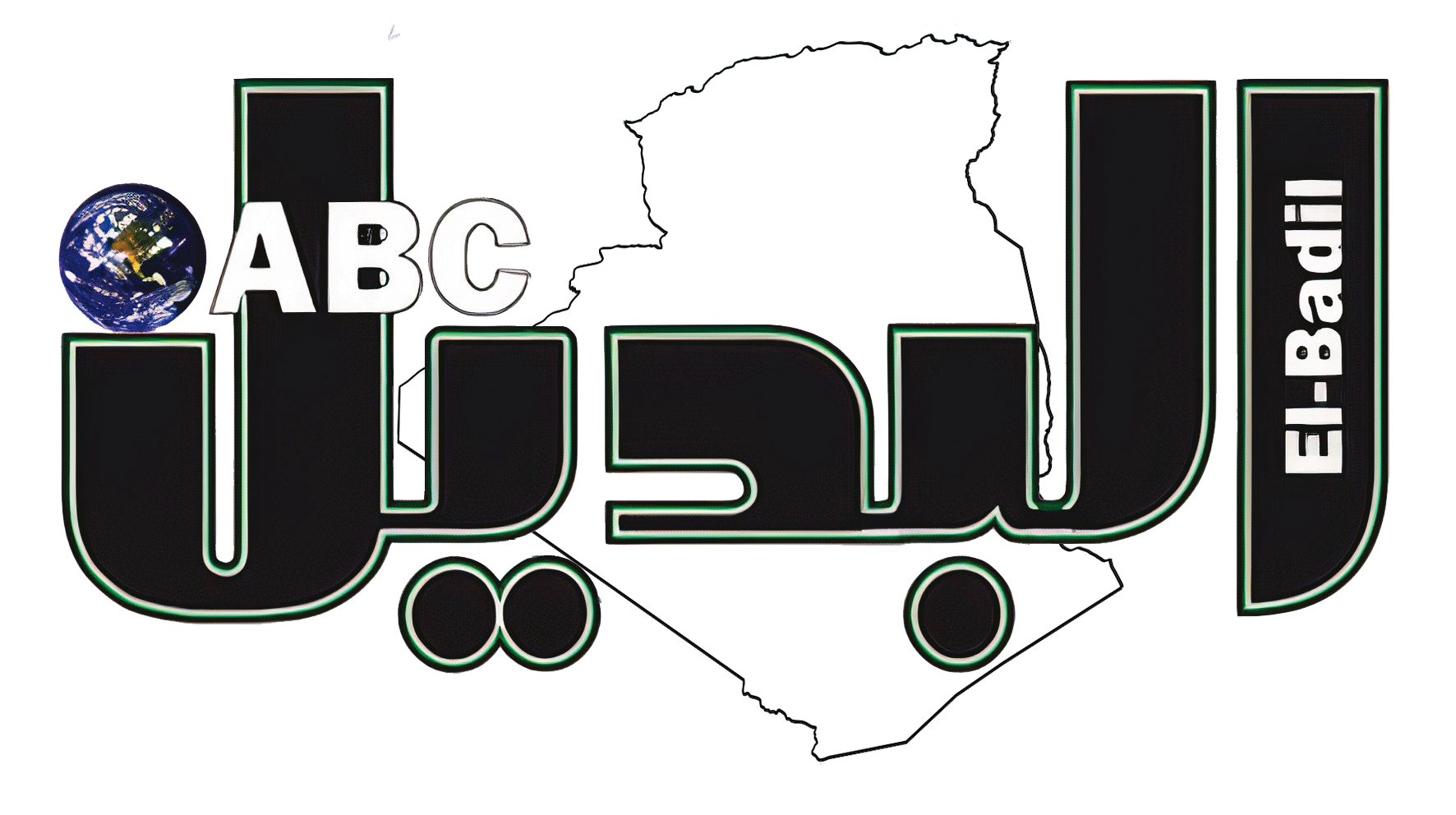المصادر التاريخية الرقمية .. على عتبة القرن الواحد والعشرين. بدأ المؤرّخون يركّزون جلَّ اهتمامهم على استيلاد وصياغة ما يمكن أن نسمّيه “إنتاج المصادر التاريخيّة الإلكترونيّة”. وبلورة منظومة متكاملة من المصادر العلميّة التي يمكن أن تتحوّل إلى مكتبات شاملة تصل إلى أكبر عدد ممكن من المؤرّخين. والمهتمّين في مجال الأبحاث التاريخيّة. كما في اختصاصات متنوّعة في العلوم الإنسانيّة. هذا التحوّل الكبير فتح أمام العلوم التاريخيّة إمكانيّات جديدة لا حدود لها.
المصادر التاريخية الرقمية..
ويمكننا اليوم أن نجد في الشبكة العنكبوتيّة مئات الالاف من المصادر والكتب. وكذا الوثائق التاريخيّة بصورتها الأصليّة. إلى مئات النصوص المصوّرة ضوئيًّا بواسطة الماسح الضوئيّ. الذي مكَّن من الحصول على عدد لا يحصى من الرسومات والصور. التي تمّ تحويلها إلى صور رقميّة تتناسب مع حاسوب بسيط.
أو أيّ جهاز خليويّ كوسيلة سهلة لتخزين هذه المصادر داخل الملفّات. واسترجاعها عند الحاجة إليها. ثمّ نسخ المستندات وإعدادها.منها الوثائق النادرة جدًّا عن تاريخ الحضارات القديمة والوسيطة. ومواضيع عن بعثات أنتروبولوجيّة وأركيولوجيّة ومدوّنات ومذكّرات رحّالة، ومجموعات لا حصر لها من الصور النادرة والقيّمة.
المصادر التاريخية الرقمية .. عالم تزدهر فيها الثورة الرقميّة
من دون أدنى شكّ فإنّ المؤرّخين الذين يعيشون في عالم تزدهر فيها الثورة الرقميّة. بدا وكأنّه فتحت أمامهم إمكانيّات ومُناخات لا تحدّها حدود. الأمر الذي يفتقده أولئك الذين لا زالت بلدانهم متأخّرة في هذا المجال. والذين لا تزال تقنيّات المعلومات في طورها البدائيّ. أو تعاني من عدم قدرة على مواكبة المتغيّرات السريعة الذي يشهدها هذا الفضاء.
في هذا السياق وكمثال على ذلك، فإنّ إدارة الأرشيف والوثائق الوطنيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة (NARA). الذي يضمّ ما يقرب من مئة وعشرين ألف وحدة. تمّ مسحها ضوئيًّا وتحويلها إلى نسخ رقميّة، وتمّ نشرها عبر الإنترنت على موقع (NARA) ليصل إليها كلّ من يرغب في ذلك.وتضمّ هذه الوثائق، والمصادر الممسوحة ضوئيًّا. آلاف النصوص، والصور، والخرائط.والجداول المرتبطة بمراحل تاريخيّة عن تاريخ الولايات المتّحدة الأميركيّة، فمن بين الوثائق التي تمّ رقمنتها (معاهدة شراء لويزيانا من فرنسا عام 1803. قانون تحرير مقاطعة كولومبيا 1862، إعلان التحرير 1863، معاهدة شراء جزيرة ألاسكا من روسيا عام 1868، وغيرها).
التنقل من إطار البحث التاريخيّ التقليديّ
يمكن القول أنّه حصلت ثورة فعليّة نقلتنا من إطار البحث التاريخيّ التقليديّ: المباشر وغير المباشر، أي من مرحلة الملاحظة المباشرة والدراسات الميدانيّة – الأثريّة.والشهود والسجلاّت، إلى موضوعات باتت تقدّم لنا كلّ شيء بشكل رقميّ عبر المواقع الإلكترونيّة، ومحركات البحث مع وجود مميّزات تمنحها التكنولوجيا من خلال مجموعة من الخِدمات الافتراضيّة. وتوفير الأرشيفات الرقميّة. وفي الوقت نفسه. فإنّ هذا التحوّل نحو العصر الرقميّ بدأ يضع كيف يمكن التحقّق من مصداقيّة المصادر التاريخيّة المنشورة، أي الأصيلة. وتلك الإلكترونيّة، وكيف يمكن التمييز بين الوثيقة الأصيلة والوثيقة الرقميّة؟
فلنذهب أبعد منذ ذلك، فإذا قمنا بتنزيل نصّ تاريخيّ من الشبكة. أو من موقع إلكترونيّ، أو ويب معيّن، كيف بالإمكان تنقيح المصدر أو الاقتباس وتثبيته. وكيف هي في الأساس آليّة الاقتباس؟ ذلك أنّ الموقع الذي جرى الاقتباس منه يمكن أن يزال. أو يُمحى، أو يُتعرّض للحظر. وكيف يمكن أكثر أن نَحُلّ مواضيع متعلّقة بحقّ الملكيّة الفكريّة عند الاستفادة من المصادر المتاحة للعموم، والمنتشرة هنا وهناك في عشرات المواقع الإلكترونيّة. وما هي أحقّيّة المقالة المقتبسة. والمنشورة على الإنترنت ومكانتها وموقعها؟
إنَّ هذه بمجملها أسئلة تحتاج إلى إجابات، وإلى حلول تضع المؤرّخ أمام جملة من المَهَمّات التي لا بدّ من حلّها. الأمر الذي يسعى هذا البحث للإجابة عن بعض منها. وأبرز هذه التعقيدات هو تقادم المصادر المطبوعة، وفقدانها لقيمتها العلميّة شيئًا فشيئًا، وتعرّضها للتلف. والاهتراء من جهة، ومن جهة أخرى إمكانيّة حصول لبس في مصدرها الأصليّ. ما يعني فقدانها لقيمتها المعرفيّة الوازنة التي تخدم في الأساس أصول البحث العلميّ، وهذا ما يؤدّي تدريجيًّا إلى نسيانها الكلّيّ، وخروجها عن السِّكّة المعرفيّة.
المصادر التاريخية الرقمية .. إتقان سبل الاستخدام المعرفيّ
لقد بات من الضروريّ على المؤرّخ أن يتقن أوّلًا سبل الاستخدام المعرفيّ بما توفّره الشبكة الرقميّة، ثانيًا التأكّد من الدقّة، والجودة، والأصالة من خلال معرفة تقنيّات البحث واحترافها وتقنيّات التثبت من أصالة المادّة الإلكترونيّة. وعلى طريق تأسيس مكتبات وطنيّة رقميّة، فإنّ العمل مع الأرشيف يعدّ مسألة بالغة الدقّة. وتحتاج إلى ترتيبات وإجراءات بما فيها تلك المتعلّقة بأمن الدولة، وحماية مصادرها التاريخيّة، وسرّيّة المعلومات حفاظًا على الاستقلال الوطنيّ في مجال تسريب المعلومات والوثائق ذات الطابع الوطنيّ كجزء من التراث والثروة الوطنيّة. وتحديد سقف السماح للباحث بالوصول إلى كمّ محدّد من المعلومات، بما لا يضرّ بالمصلحة الوطنيّة والسياديّة، إذ إنّه من الضروريّ سنّ قوانين ووضعها، وتشريعات وطنيّة تحدّد مستوى الوصول والولوج إلى هذه المعلومات، والمصادر، الأمر الذي تتّبعه المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، والأرشيف الوطنيّ في الولايات المتّحدة، والمكتبة الوطنيّة في روسيا.
أهمّيّة البحث ومبرّرات اختيار الموضوع
إنّ من بين أكثر المصادر التي تحتاج إلى التدقيق، ومراعاة الدقّة في عمليّة الاقتباس، والاستشهاد هي المصادر التاريخيّة، ولذلك تبقى المخطوطات، والنصوص التاريخيّة المصورة معرّضة للتحريف والتشويه بما يفقدها أهمّيّتها التاريخيّة، ومكانتها كمرجع علميّ موثوق به، بالإضافة إلى الكتب القديمة التي تعدّ مراجع تاريخيّة مُهِمَّة، والتي يعود تاريخ نشرها إلى قرن ونصف من الزمن. وبما أنَّ هذين المصدرين يعدّان من بين أهمّ المصادر في البحث التاريخيّ، فكيف الحال في البحث التاريخيّ الرقميّ الذي يلجأ إليه المؤرّخ خلال كتاباته لأبحاثه ودراساته، حيث من المهمّ هنا الاعتماد على الدقّة المتناهية، خصوصًا في ظلّ وجود مجموعة كبرى من المصادر الإلكترونيّة، أو مصادر الإنترنت سواء المجانيّة منها أم المدفوعة سلفًا بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيّ – الرقميّ، التي تتخصّص في هذا المجال لتأمين المادّة عبر بيعها ونشرها.
من هنا يركّز هذا البحث على أهمّيّة إتقان فنّ التعامل مع وسائل النشر الإلكترونيّ التاريخيّ على شبكة الإنترنت، التي تُتيح للباحث، والدارس، والمؤرّخ، وطالب الدراسات العليا إمكانيّة نشر وإعادة نشر أبحاثه، والولوج إلى المكتبات الإلكترونيّة عبر العالم، والتواصل مع الجمعيّات العلميّة التاريخيّة، والعلماء، والمؤرّخين بواسطة الشبكة العنكبوتيّة، والإسهام في المؤتمرات العلميّة من خلال المشاركة الرقميّة.
من هنا فإنَّ أهمّيّة هذه الدراسة تكمن في مساعدة المؤرّخ على التحقّق من المصادر التاريخيّة الإلكترونيّة في الفضاء الرقميّ الشاسع، وإلقاء الضوء على أهمّيّة الانتقال التدريجيّ نحو البحث الإلكترونيّ التاريخيّ الرقميّ بما يواكب المتغيّرات الحاصلة في العلوم التاريخيّة على مستوى العالم أجمع.
أهداف البحث
إنّ هذا التحوّل يحتاج إلى توفّر الكثير من الظروف والعناصر، ولذلك من بين أهمّ أهداف هذا البحث ما يلي:
أوّلًا: وضع نماذج وأشكال مقترحة ومعتمدة للنشر الإلكترونيّ يراعي المتغيّرات التي تحصل في هذا المجال ويتناسب مع معايير النشر، والبحث، والتقويم لمصادر المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، بغرض قياس درجة المصداقيّة والدقّة.
ثانيًا: المساهمة في تقديم أفضل المعايير لتحكيم مصادر المعلومات الإلكترونيّة التاريخيّة، ذلك أنّ هذه المعايير التقويميّة يجب أن تعتمد على حقوق وقواعد واضحة، ومنها: حقّ الملكيّة الفكريّة ونُظمها وقواعدها، المسؤوليّة الفكريّة (حقّ التأليف والمؤلّف)،المضمون، الدقّة العالية، تحديث المصادر، طرق الاستشهاد المرجعيّ الرقميّ الدقيق.
ثالثًا: من بين أهمّ أهداف هذا البحث هو كيفيّة الاعتماد على مقياس الجودة العلميّة، ودرجة الوثوق بالمصادر الرقميّة لأغراض كتابة الأبحاث العلميّة التاريخيّة.
إشكاليّة البحث وتساؤلات الدراسة
نرى أنّ الإشكاليّة الأهمّ في هذه الدراسة تكمن في عدم وجود “داتا” للمصادر والمراجع التاريخيّة العربيّة. واضطراره للجوء إلى مصادر، ومواقع، ومحرّكات بحث مشكوك فيها وغير علميّة وعشوائيّة. من هنا يحاول البحث طرح إشكاليّات عدّة منها:
– ما هو مفهوم البحث التاريخيّ الرقميّ. وماذا تعني الشبكات الرقميّة، وقواعد المصادر، ومحرّكات البحث؟
– كيفيّة التفريق بين البحوث التقليديّة. وبين خِدمات المعلومات التاريخيّة الرقميّة التي تقدّم عبر المواقع على شبكة الويب؟
– هل يمتلك الباحث – المؤرّخ المعارف. والمهارات اللازمة الرقميّة التي تمكّنه من العمل في البيئة الرقميّة؟
فرضيّات البحث
الفرضيّة الأولى: البيئة الرقميّة توفّر إمكانيّة هائلة للباحث في مجال العلوم التاريخيّة. وواجب إتقانها أصبح ضرورة لتطوّر العلوم التاريخيّة بتنوّع تشعّباتها.
الفرضيّة الثانية: المصادر، والوثائق، والمخطوطات المصوّرة تحتفظ بأهمّيّتها العلميّة. والتعامل معها لا يقلّل من أهمّيّها وجودتها ومصداقيّتها.
الفرضيّة الثالثة: تمكّن طرق البحث الرقميّ. والبحث الوثائقيّ داخل البيئة الرقميّة إمكانيّة استرجاع وثائق يحتاجها توفّره الشبكة العنكبوتيّة، الأمر الذي يفترض تهيئة البيئة الرقميّة لتلائم هذا التحوّل في العلوم التاريخيّة.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج المسحيّ التقريبيّ للعديد من النماذج، والمصادر التاريخيّة المنشورة في المكتبات الرقميّة العربيّة الموجودة على شبكة الإنترنت. ومستوى إعدادها، وسهولة الولوج إلى المعلومات. ومستوى الدقّة والأمانة العلميّة ومنها (مكتبة فلسطين للكتب المصوّرة، مسابقات ومعرفة، الوثائق البريطانيّة، مكتبة أبو العيس الإلكترونيّة، مكتبة التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة التاريخ – لبنان – اليونان – الشرق الأوسط – الوطن العربيّ وغيرها).
كما استخدم الباحث المنهج التحليليّ لما لهذا المنهج من فائدة في رصد خِدمات المعلومات التي تقدّم للباحثين على بعض المواقع المحلية والعربيّة على شبكة الويب ومعرفة مدى تلبيتها لاحتياجات المستفيدين (سوق عكاظ، مكتبة القراء العرب. مدونة مكتبة الياسين، المكتبة التاريخيّة والسياسيّة واحد واثنين…). وإمكانيّة الاستفادة من تكنولوجيا الويب في إتاحة السجلاّت والملفّات الرقميّة إلى اكبر عدد من المستفيدين.