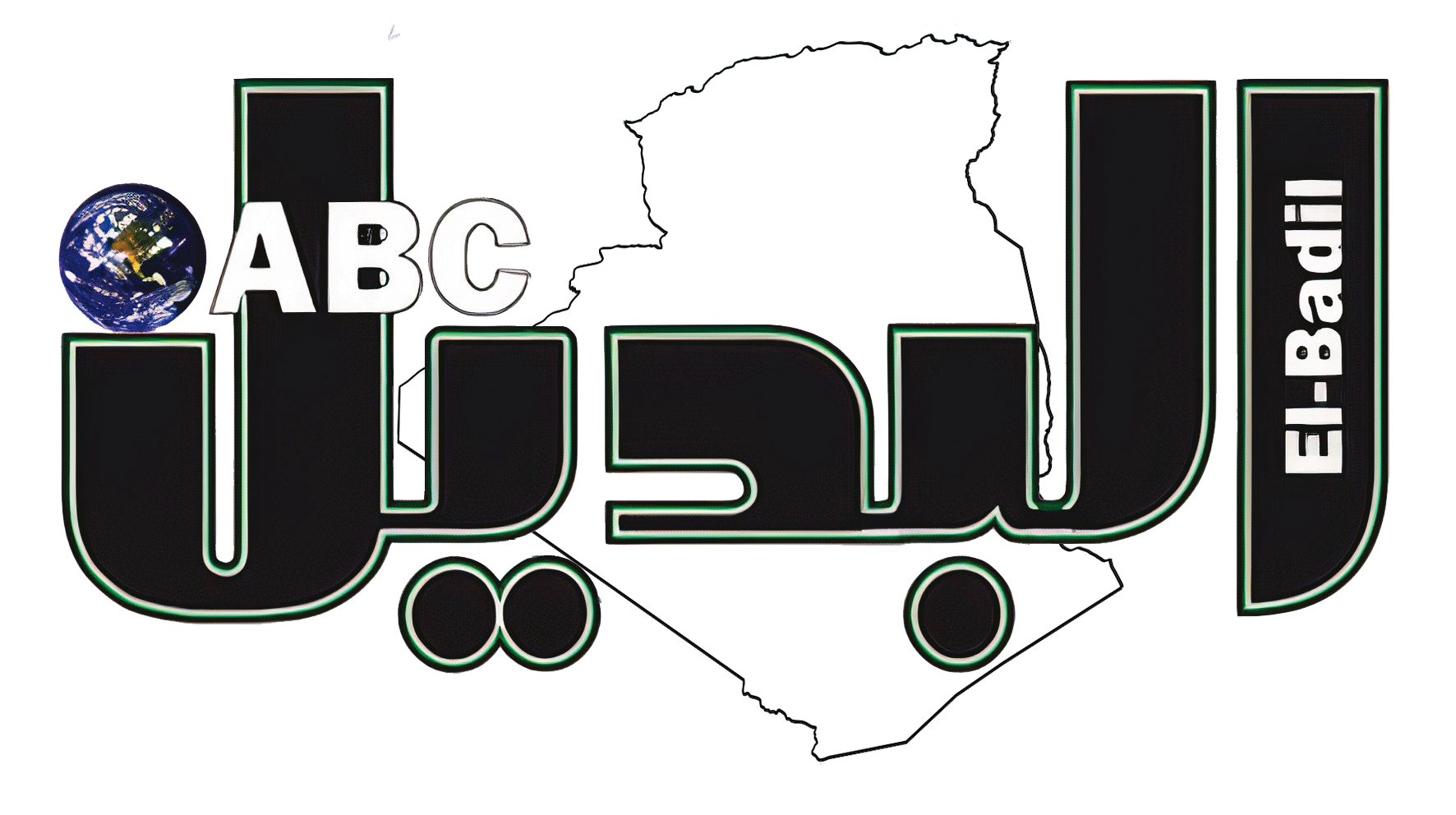تعتبر ثالث الكفيفات في الأسرة من بين 4 إخوة مكفوفين (ثلاث بنات وولد)، درسوا جميعا في مدرسة المكفوفين حتى نالوا شهادة المتوسط، لكنها كانت المميزة في أسرتها، فقد حققت شهادة المتوسط لتنتقل إلى الثانوي وبعد نجاحها في شهادة البكالوريا في 2010، اختارت تخصص علم النفس في الجامعة وكانت الأولى في دفعتها سنة 2013، واصلت دراسة الماستر في نفس التخصص وتخرجت في 2015، وفضلت رفع التحدي ودخول مسابقة الدكتوراة وكان النجاح حليفها فتخرجت في 2022.
لم تتوقف عند حدود الدراسة، فقد كان لها مسار في عالم الشغل، الذي دخلته عن طريق الصدفة، واكتسبت خبرة في التعامل مع الآخرين أو المختلفين عنها، رغم قصر المدة، التي تنقلت من خلالها بين 3 مؤسسات عمومية (مركز الطفولة المسعفة بوهران، مؤسسة تعليمية تابعة لمديرية الصحة بوهران وشركة تابعة لمديرية النقل أيضا بوهران)، في إطار عقود ما قبل التشغيل كأخصائية نفسية، أعطتها الفرصة لتكوين فكرة ومعلومات سهلت لها التعامل مع طلبتها اليوم بالجامعة، بعدما كسبت منصب أستاذة جامعية، لتزاول مهنتها التعليمية بجامعة مستغانم منذ 2023 إلى اليوم.
إنها الطموحة “مريم بلفول” من مواليد 1990 بولاية وهران، ولمعرفة سر سطوع نجمها في عالم العلم والمعرفة، تقربت منها جريدة “البديل” وكان لنا معها هذا الحوار:
كيف قررت عائلتك الاهتمام ودمجك بالمدرسة؟ وهل تعرضت للتنمر؟
مرحبا، لقد كانت عائلتي واعية بالمرض من البداية، وقد أدمجونا كلنا كإخوة في مدرسة المكفوفين بطريقة عادية. لكن أكبر صعوبة كنا نتلقاها خلال تعليمنا هي أننا كنا داخليين، أي نمضي الأسبوع بالمدرسة بعيدا عن بيتنا وأحيانا كنا نتعرض لسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين، خاصة خلال الفترة الليلية، بينما كان الأساتذة يتعاملون معنا بأسلوب راق. وقد كنا نتعرض للتنمر ونحن صغار، خاصة لدى خروجنا للعب في الشارع مع الأطفال والغرباء، إلا أننا كنا نتجاهلهم ونواصل اللعب عادي.
هل كانت عائلتك تضمن التكفل التام بدراستكم؟ وهل كانت الوسائل البيداغوجية متوفرة لكم؟
الوسائل البيداغوجية لم يكن باستطاعة عائلتي توفيرها، بل الأمر مرتبط بالمدرسة على غرار الكتاب، أدوات التعليم…، هي أدوات يصعب الحصول عليها خارج المدرسة، اللهم إلا إذا حصل التلميذ عليها من جمعيات في الخارج، وفي فترة دراستي كانت الوسائل المتاحة قليلة، وبعد تثبيت المرحلة المتوسطة 2003ـ2004، لم تكن متوفرة لنا الكتب، درسنا 4 سنوات بدون كتب، وقد كان الأستاذ “محمد لحوالي” يدرسنا اللغة العربية، فقد كان يتحمل مسؤولية طبع النصوص على الأوراق لنا، وهو نوع من التحدي، لأننا كنا نقرأ ما يدرسه تلاميذ المتوسط العاديين، لكنه يتحمل مسؤولية كتابة ما يدرسونه هم بالطريقة التي تساعدنا على القراءة بطريقة بسيطة.
وبعدها بدأت عملية توفير الكتب للمكفوفين، لكن في السنوات الأولى كان البرنامج الدراسي دائم التغير، بينما كنا نعاني عندما تتلف وسائل الدراسة كالوسائل المستعملة في الرياضيات لأنها خاصة بالمكفوفين، وكان صعب الحصول عليها لأنها قادمة من الخارج، وقد ساعدتنا في هذه الناحية “الأخت دانيال” التي كانت دائمة المساعدة لنا.
بالنسبة لعائلتي، كان التحدي أكيد كل يوم أربعاء يحضر والدي ليقلنا إلى البيت ويعيدنا يوم السبت، كما كان التحدي المادي، لأننا 4 مكفوفين ندرس والوضع المادي كان متوسطا، من بطيوة لعين الترك أكثر من 50كم، وقد كان غالبا ما يعاني والدي عند نهاية الأسبوع، ليصل إلينا في الموعد عند مغادرتنا للمدرسة باتجاه البيت العائلي، فأصبحت الوالدة من تقوم بالمهمة، إلى جانب صعوبة التنقل عبر الحافلة ونحن 4 مكفوفين.
كيف كانت تجربتك بالجامعة؟ كيف تعامل معك الأساتذة والطلبة وتحضير مذكرات التخرج؟
الحياة الجامعية كانت مرحلة مهمة في مسيرتي التعليمية، أولها مجموعة صديقاتي، لكن كنت معهن دائمة الالتقاء سواء للذهاب إلى المكتبة أو المطعم الجامعي، حصلت على غرفة مع إحدى الفتيات بالإقامة، وقد كانت تجربة جيدة، أصبحت أستغلها خاصة عندما تكون فترات الدراسة لساعات المساء، وكذا البحوث.
أما بالنسبة للطلبة هناك الكثير من كانوا يتواصلون معي كما كان البعض لا يهتم والأساتذة كانوا يكنون كل الاحترام لي، ناهيك عن فرضي لوجودي بينهم، فقد كنت أجلس بالمقعد الأمامي وأشارك وأسأل عما لا أفهمه. فيما يخص البحوث، فقد كنت أحبذ رفقاء في إنجازها، لكن كنت أتلقى صعوبات، لأنني كنت أحرص على الانتهاء من البحث في أقصى سرعة وأخصص له أكبر وقت من فراغي، لكنني أصطدم بتراخي زملائي، وأحيانا يتهاونون، لكنها كانت تجربة سمحت لي بالتأكد، أنه من الأفضل للكفيف ألا يشارك في تحضير البحوث مع طلبة عاديين، أي إما يكونوا في مستواه أو أعلى منه لكن أقل منه هو مضيعة للوقت والجهد. في وقت يشكل الوصول إلى المصادر صعوبة بالنسبة للكفيف، خاصة وأن الزميلات كثيرا ما يتباطأن في الذهاب إلى المكتبة من أجل قراءة المواضيع لي، لقد تعبت كثيرا، كنت أشعر بالانزعاج.
أما بالنسبة للامتحانات، فقد كانت تمر عليا بصعوبة، لأن الأساتذة يطالبونني بإحضار من يكتب لي الإجابة، فأقضي وقتا بالساحة أبحث عمن يقبل ويتطوع ليكتب لي الإجابة خلال مدة الامتحان. ومرة حدث تسريب، كانت إحدى الطالبات تقدم لي المساعدة وتكتب لي الإجابة وكانت صديقتها تدرس معي، كانت تسمح لها بنقل الإجابة من ورقتي، بينما قامت إحداهن بتدوين اسمها عوضا عن اسمي وكدت أفقد نقطتي. فالامتحانات كانت تجربة مريرة في الثانوي. بينما في الجامعة كان هناك من يساعدني والبعض لا يمنحني الوقت اللازم للرد، في فترة الدكتوراة، زادت معاناتي، لا يوجد من يصاحبني للمكتبة، زملائي لم يعد لهم وجود، كل له انشغالاته، فصعب علي جمع المعلومات. بينما اليوم كوني أستاذة، فأنا أتلقى تعاملا محترما من طرف زملائي الأساتذة وكذا طلبتي.
ما هو موضوع أطروحتك للدكتوراه، ولماذا اخترته؟
أطروحة الدكتوراه كانت حول “الاختيار الزواجي على أساس المال والجمال والنسب والدين، في ضوء المستوى التعليمي والاجتماعي”، وذلك بحكم أننا نعرف أن الطلاق من أسبابه سوء الاختيار، وقد توصلت فيه إلى نتائج واقعية، أكدت وجود فروق بين المطلقين والمتزوجين، كما لاحظت أن الرجال يركزون على الجانب الديني أكثر من النساء، بينما تركز المرأة على الجمال أكثر مقارنة بالرجل.
هل كان التحاقك بمنصب الشغل صدفة أم عبر وساطة؟
عملي كان بالصدفة، فقد رافقت صديقتي لإيداع طلبها منصب العمل بمؤسسة الطفولة المسعفة بوهران، وفي الطريق دعتني لإيداع طلب ربما أنجح في الحصول على منصب عمل، وقد حدث فعلا، وتم قبولنا وبدأنا العمل بأجرة لا تتعدى 9000 دج، تابعتين لمديرية النشاط الاجتماعي، وقد واجهتني صعوبات كبيرة جدا بالمهنة، كان أولئك الأطفال المسعفين يتنمرون عليا بشدة وقد وصل الأمر بهم إلى رميي بالأشياء التي يجدونها، وهم أصلا لا يتقبلون الغرباء، يتفاعلون جيدا مع العمال الدائمين هناك.
وقد اجتهدت رفقة زميلاتي هناك لوضع برنامج عمل لانعدام خطة عمل بالمؤسسة، وبعدها تنقلت إلى مؤسسة تعليمية تابعة لمديرية الصحة، ثم بإحدى شركات التابعة لمديرية النقل، بدأت هناك العمل كأخصائية مع الكبار، وقد كانت تجربة رائعة سمحت لي بمعرفة مستواي المهني، لأشارك في مسابقة التوظيف بالجامعة، وقد نجحت في ذلك واليوم أنا بجامعة مستغانم.
بما أنك تعاملت مع الأطفال، لماذا طغت بعض الأمراض النفسية على الطفولة، رغم ما توصل إليه العلم والتطور المجتمعي والمعيشي؟
هناك عدة أسباب أصبحت تؤثر على سلامة الأطفال من الناحيتين النفسية والسلوكية، قبل الحديث عن الأسباب النفسية، هناك أسباب عضوية، ناتجة عن تغذية الأم الحامل، التي تختلف طبيعة طعامها عن المرأة الحامل في سنوات خلت، كانت تعتمد على تغذية طبيعية وصحية، عكس نساء اليوم، لا تهتم وتعتمد على الأكلات الجاهزة والسريعة، لأن الغذاء غير صحي، عدم ممارسة الحركات الرياضية، نقص الفيتامينات، هذا ما يجعل الطفل يعاني من طيف التوحد.
بينما الانطوائية والعزلة عند الأطفال، هي نمط من أنماط الشخصية، إلى جانب عدم تكتل الأسرة وانقطاع التواصل بين أفرادها، حيث نجد امرأة لا تعلم ابنها الكلام والتحدث، وبعد مرور وقت تنطلق في البحث عن طبيب معالج له، وتشتكي من تأخره في الكلام، بسبب اهتمامها بالإنترنت والمسلسلات، أمهات اليوم لديهن حماية زائدة، في الماضي كانت المرأة تلد كثيرا من الأطفال، وهم يعتمدون على بعضهم في تلبية حاجياتهم وحماية بعضهم في الشارع، اليوم أصبحت الأم تفرض طريقة حادة في التعامل مع الطفل، إضافة إلى منح الأجهزة الإلكترونية للطفل، على غرار اللوحات الالكترونية والهواتف الذكية، وهو ما يخلق لديه إدمان على التكنولوجيا ويضعف رصيده اللغوي، ويؤخره عن الكلام، ناهيك عن الأمراض والاضطرابات في السلوكيات مثل عدم تحكم الأطفال في الألعاب الكلاسيكية، إلى جانب غياب الانتباه لدى الأولياء وتركيزهم فقط على تحصيل نتائج جيدة، عوض تبادل الحب والحنان وتحسيس الطفل بمركزه في المجتمع. إذن التطور التكنولوجي والمعيشي ساهم في تعقيد الحياة.
قمت بدراسة علم النفس الأسري، ظاهرة الطلاق كثرت، رغم أن تعارف الزوجين أصبح يتم قبل الزواج عكس الزواج في الماضي، عن جهل ببعضهما، ما السبب؟
التعارف في الواقع الافتراضي غالبا ما يكون سببا في سرعة الطلاق، لأن العيش في الواقع بين الطرفين يكشف حقائق أخفاها التواصل الافتراضي، ناهيك عن استغلال التطبيقات لتعديل صورهم وتقديم معطيات غير صحيحة عن أنفسهم، ليصطدموا بالواقع وتظهر الحقيقة التي تجعلهم يفقدون الثقة فيما بينهما، وبالتالي يضيع الحلم.
الأجيال الصاعدة لا تتمتع بتربية جيدة مثل الأجيال التي سبقتها، إلى جانب غياب التأهيل الذي يسبق الاختيار للزواج، كتعليم الفتاة طريقة الحديث، تحديد المسؤوليات، التعامل مع الغير…، كذلك بالنسبة للولد، وهو ما يخلق عدم توازن في العلاقات ويسرع في الطلاق، لأن التركيز على المظاهر أصبح الأهم، ناهيك عن الاضطراب في الهوية، الذي جعل الأنثى تبحث عن أخذ دور الرجل، في وقت تقرب الأم ابنها منها إلى درجة كبيرة، تجعله يتخلى عن تحمل مسؤوليته كرجل، فالتكنولوجيا والإعلام أصبحا من أسباب الطلاق لأنهما يقدمان نماذج مثالية تخلق الرغبة لدى المتلقي للتشبه فيها على أرض الواقع، كالمسلسلات والنماذج المقدمة في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، هل ساعدتك هذه الأساليب العملية الجديدة في عملك وحياتك اليومية؟ في الجزائر هل توجد أرضية تكنولوجية تساعد فئتك والفئات الخاصة في تعليمهم؟
نحن كمكفوفون نعتمد عليه في القراءة من خلال قارئة الشاشة، لكن أنا شخصيا تعاملي محدود بالذكاء الاصطناعي لأنني حديثة العهد به، وألجأ له للحصول على إجابات على أسئلة عادية لبحوث ومعلومات عن بعض المواضيع. ورغم وجود تطبيقات تساعد على قراءة النصوص، إلا أنني أطمح إلى الوصول إلى التخلي عن المبصرين نحن كمكفوفين، حتى لا نزعجهم بطلب مساعدتنا على القراءة، أحيانا يتوقف برنامج القراءة فنضطر إلى طلب المساعدة لمواصلة القراءة، وهذا من سلبيات التكنولوجيا.
أنا متقبلة لوضعي، ومن الصعوبة الوصول إلى الوثائق، الحصول على وسائل البيداغوجيا، التنقل والتحرك من منطقة إلى أخرى… إلى جانب الإيجابي الذي يعطينا فرصة التعرف على الآخرين، خدمات مقدمة في مجالات الغير… لأن فقدان البصر جزء من الكل، وبالرغم من أننا مكفوفين، إلا أننا نتعرف على نمط التعامل مع الأشخاص الآخرين، بناء على نبرة الصوت.
حاورتها: ميمي قلان