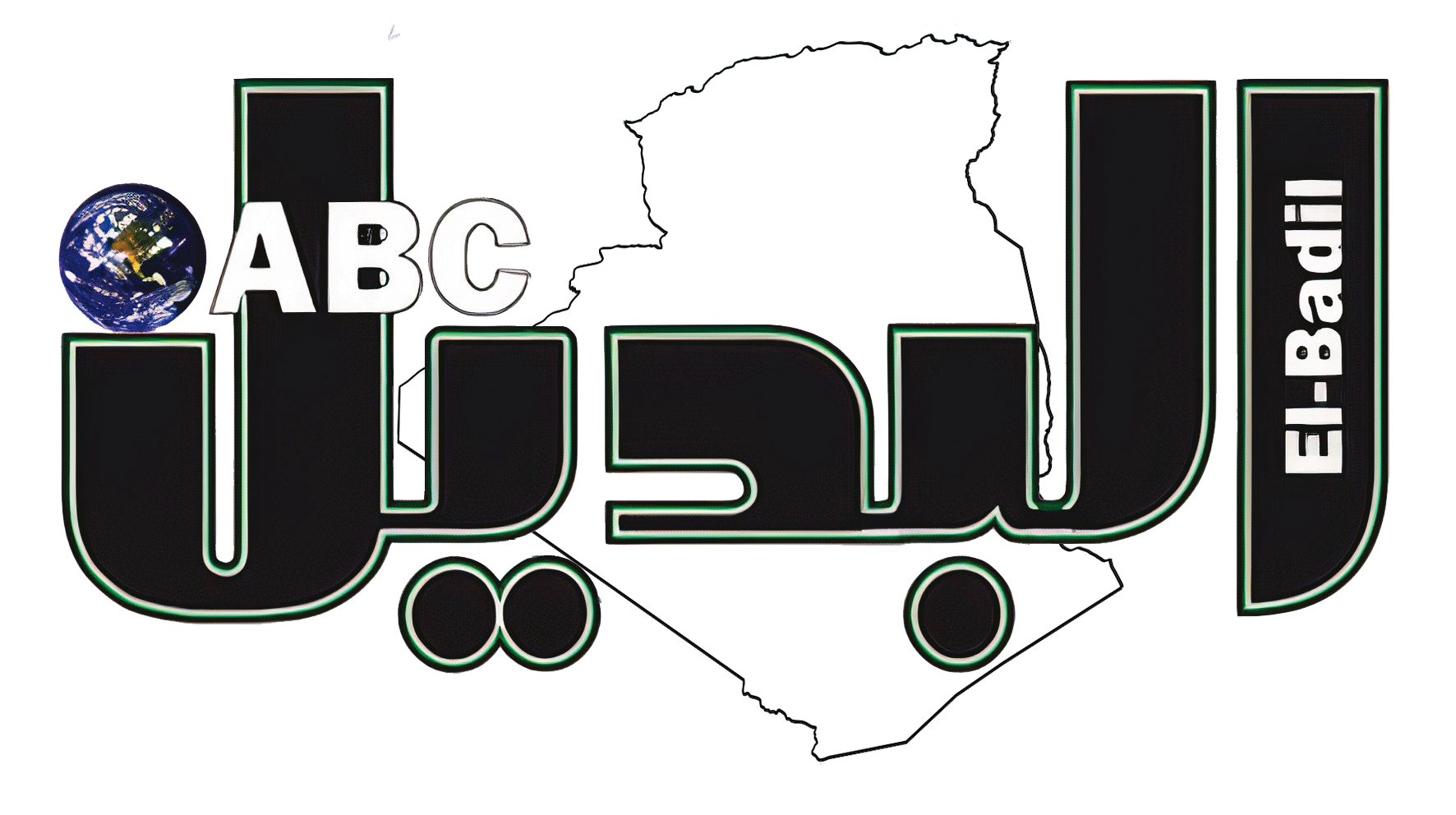ينادونه “أبو الفقراء”، فقد غلب سخاءه طباعه،واحتواءه للمحتاج للمساعدة المادية، النصيحة والرأي السديد، ولو على حساب صحته وجهده الفكري بعدما تجاوز سن الـ 84 سنة، وتحمل مسؤولية خدمة الوطن خلال الثورة التحريرية منذ صغره إلى مسؤولية خدمة الشعب والدولة بعد الاستقلال عبر مختلف المناصب التي شغلها كإداري وكسياسي، واستمراره في مساعدة المواطنين ممن يقصدونه إلى اليوم. إنه ابن المجاهد الفذ “خالد حدو”.
زارته جريدة “البديل” بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وكان هذا الحوار المقتضب حول ما عاشه خلال الثورة التحريرية، وكيف كان يرى الجزائر في شبابه وكيف يرى جزائر الغد مرورا بجزائر اليوم:
كيف كانت طفولتك؟
لقد وجدت نفسي ثوريا دون تحضير مسبق، وذلك لأنني ولدت في عائلة ثورية، فوالدي كان يملك قصابة وفي نفس الوقت مطعما شعبيا، وهو معروف باسم “موح البوشري”، ومطعمه باسم “كول وروح”، لأنه لا يقبض على الجزائريين الذين لا يملكون مالا، ولا يطالبهم بالتسديد، فأصبح معروفا بـ “مطعم موح، كول وروح”، بينما كان الفرنسيون يأكلون مجانا ويأخذون اللحم عنده خاصة أحد قادة الشرطة، ولم يكن والدي يرفض لأنه يعلم أنه في حال اشتكى أو امتعض، يمكن أن يفقد مصدر رزقها نهائيا.
وقد لبى نداء الوطن من البداية، فقد انخرط في الحركة الوطنية، جبهة التحرير الوطني، بينما والدتي كانت تخدم المجاهدين وتجندنا ونحن صغار لإيصال بعض الأشياء إلى أشخاص معينين ومناطق محددة، كما كانت تحرص على تعلمنا “حفظ السر” والتمسك بالإنكار في حال كشف أمرنا، وقد كان فارقا في طفولتي وأنا في سن 13، عندما أحرزت الشهادة الابتدائية في التعليم، فقد كان حدثا استثنائيا في الحي الذي أقطنه كجزائريين وكنا حينها معروفين بـ “الأهالي”، وهو الأمر الذي استفز المعمرين بجوارنا لأنهم كانوا يروننا أقل قيمة منهم وليس من حقنا تحقيق نتائج جيدة فيما يتقنونه كالتعليم.
لكن ما بقي عالقا في ذهني ورسخ في ذاكرتي هو يوم الاحتفال ذاك، الذي وافق 15 جوان 1954، فقد كان أول مرة في حياتي أعيش شعور تصفيد اليدين، بعدما حضر رجال الشرطة الفرنسية إلى بيتنا الذي كان يتواجد بوسط مدينة تيارت وبالضبط 39 شارع الجنرال بيجو. وضعوا لي الأصفاد واقتادوني إلى مركز الشرطة، بقيت هناك لساعات، خضعت فيها وأنا طفل لتحقيق عسير حول أسباب وأهداف احتفالي بنجاحي في شهادة التعليم، قبل أن يطلق سراحي وأعود إلى البيت والخوف يسكنني.
كيف التحقت بالثورة؟
وبالإضافة إلى التعليم فقد كنت رياضيا، وقد التحقت بالكشافة الإسلامية، إلا أن والدي أكد لي أن الرياضة والكشافة الإسلامية لن يسمحا لي بتولي منصب عمل، وحتى التعليم، لأن الفرنسيين يروننا عبيدا عندهم ولا يسمحون لنا بتقلد مناصب حسب المستوى التعليمي، فتوجهت إلى عالم الميكانيك، وقد أصبحت بارعا فيه، أفكك لواحق المركبة وأعيد تركيبها.
وأنا أجري تربصي بمحل تصليح السيارات، اكتشفت أن رئيس العمل “خوجة قصبة ابراهيم” عم “نورالدين”، عندما ينتهي الدوام ويحل الظلام، كان ينظم اجتماعات بالمحل مع مناضلي جبهة التحرير الوطني بتيارت. وقد كان متحدثا وطنيا بارعا وكان صوته يضاف إلى إذاعة صوت العرب في شحذ النفس وإقناع الجزائريين بالثورة وأهميتها في نيل الاستقلال. وبعد فترة التحقت بالثورة الجزائرية كـ “فدائي” في 1958، وقد نجحت في عديد العمليات الفدائية دون أن يكتشف أمري، على غرار عمليات سرقة السلاح الفرنسي وتحويله إلى المجاهدين.
ذكّرنا ببعض العمليات الفدائية التي مازالت راسخة بذهنك؟
مازالت إلى اليوم عملية نقل 5 قنابل من بيتنا إلى أحد المجاهدين من أجل تنفيذ عمليات تفجير بين الفرنسيين، دون أن أثير انتباه أي شخص، حيث قامت أمي بوضع القنابل في قفة وقامت بتغطيتها بحبات الرمان، ولقنتني جملة أرددها بشكل عادي في حال تم سؤالي، ولتشتيت الأنظار، رافقتني شابة جزائرية هي أيضا منخرطة في شبكتنا، ولأننا كنا في حي الأهالي بجوار أحياء ومرافق المعمرين، فقد كان هناك ممر محكم الغلق وبحراسة مشددة حتى لا يدخل أيا كان ولكشف المجاهدين والمبحوث عنهم من طرف العسكر الفرنسي.
حملت القفة وعندي اقترابي من نقطة التفتيش، تأبطت ذراع الفتاة معي، وبدأنا في تبادل الحديث والضحك، وصلنا إلى نقطة التفتيش، سألني العسكري الفرنسي: ماذا تحمل في القفة؟، ولأنني أتقن جيدا الفرنسية، فقد أجبته بطلاقة:Les Grenades،فاندهش قائلا: ماذا؟. فرفعت الغطاء عن القفة، وأجبته: طبعا. وأشرتإلى الرمان، قائلا: هل تريد بعضا منها. فتنفس وعاد إلى هدوئه، وتناول حبات، ثم سمح لنا بالانصراف، واصلنا طريقنا إلى هدفنا، التقينا الشخص المعني، سلمته القفة وغادرنا.
وهناك عملية مريرة مازالت صورتها شاهدة بين عينيا، عندما اكتشفوا أنني سرقت السلاح، فحولوني إلى الكناندة بالقرب من منداس بغليزان، ومنها إلى فرطاسة، وعندما أركبوني الهليكوبتر، وجدت مجاهدَين جزائريين مكبلين، بعد ارتفاعنا عن الأرض، رموا الأول ثم الثاني، وقد بقي صدا صوتهما في الجو “الله أكبر، تحيا الجزائر”، يردد بأذني إلى اللحظة. وعندها قال لي الجندي الفرنسي: هذا مصير كل من يتمرد على فرنسا. وقد نجحت فيما بعد في العرب من المركز، وقد كانت وصلتني رسالة من المجاهدين، بأن سيارة معينة تنتظرني بمكان معين في توقيت محدد من أجل نقلي إلى مكان آمن، لأن أمري اكتشف لدى الفرنسيون بعد تسجيل عديد العمليات السرقة للسلاح، خاصة أنني كنت أتعامل مع الفرنسيون كمدرب رياضي، وهذه العملية تعتبر الأخطر لأنني ركبت سيارة “جيپ” مليئة بالسلاح، قمت بسياقتها والتوجه نحو باب المركز والهروب وقد نجحت في العملية، بعدها تم الالتقاء في النقطة المعلومة مع المجاهدين، أين تم إفراغها من السلاح وتحويلها إلى سيارتك وانطلقنا نحو الجبل. وغيرها من العمليات التي حققنا فيها فوزا كبيرا بخسائر أقل ونجوت في مرات عديدة من الموت المحتوم.
كيف كنتم تفوزون على العسكر وتهزموهم رغم قلتكم؟
يبدو للعيان أننا قلائل، لكن إيماننا القوي بالله سبحانه وبقضيتنا العادلة، كانا من أهم العناصر التي نرتكز عليها في عملياتنا، وقد نجحنا، لأن الخوف يتبدد ونشعر بالفخر والسعادة ونحن نقدم على تحدي العدو.
وقد ساعدنا في ذلك الذكاء الذي يتمتع به الفرد الجزائري، فقد كنا نفتعل الهوشات بين الأطفال عندما يكونون يلعبون، ويتقدم أحدهم إلى المركبة الفرنسية فيفتح غطاء الوقود ليتسرب، بينما الفرنسي منشغل بمتابعة شركة الأطفال، وعندما نخطط لاختطاف أصحاب المركبة، فإننا نكون قد حددنا المسافة التي ستتوقف فيه بعد نفاذ الوقود المتبقي، لنهجم عليها ونقوم بمهمتنا.
كما ساعدنا الجزائريون الذين يشتغلون في منازل الفرنسيين ومزارعهم بالأخبار والمعلومات، كنا أيضا نستغل الأسواق والفضاءات التي تكثر بها الحركة فننفذ عملياتنا، والكثير من العمليات بفضل حفظ السر وتطبيق تعليمات جبهة التحرير الوطني.. وقد استشهد الكثير أيضا من شعبنا لننعم اليوم بالاستقلال.
بعد الاستقلال، ماذا كانت وجهتك؟
حصلت على رخصة السياقة في عمر 17 سنة، وقد تكفل والدي بالوكالة لأنني كنت قاصرا حسب القانون آنذاك.وكنت على دراية كبيرة بالمركبات والسباقة، فاشتغلت بمصلحة رخص السياقة بسيدي سنوسي لبلدية وهران، وقبلها كنت أشتغل بديوان ولاية تيارت، ثم أصبحت خبيرا في مراقبة المركبات والتجهيزات الصناعية، وفتحت مكتبا خاصا.
غير أنني لم أتخل يوما عن نداء وطني، لأنه يسكنني لست وحدي فغيري شعب بكامله، كل واحد يحبها بطريقته ويخدمه بطريقته. وقد كنت خلال الثورة ضمن كتيبة مجاهدين ضمت أشخاصا من خيرة هذه الأمة، خدموا الجزائر أثناء الثورة وواصلوا بعد استقلالها، على غرار “مصطفى لهبيري” الذي شغل عدة مناصب هامة، آخرها المدير العام للأمن الوطني “الشرطة”. وكذا الراحل “عبد القادر حجار” والحارس الشخصي للزعيم الراحل “هواري بومدين” وغيرهم، من الرجال الذين لم يتخلفوا لحظة عن نداء الوطن.
هل تجد فرقا بين رجال الأمس واليوم؟
يظن البعض أن الجيل الجديد لا يهتم بوطنه كما كان الجيل الذي سبقه، لكن هذه النظرية تسقط في الماء، بمجرد تذكر ملحمة السودان، يجب أن نرى بوضوح ظروف الأمس والحاضر الذي نعيشه، ما توفر في الماضي هو استعمار وقد جاهدناه بالنفس والنفيس.
اليوم العالم تطور وأصبح يعيش ظروفا مختلفة تماما لا علاقة لها بظروف الماضي، فقد أصبحت التكنولوجيا والتطور العلمي تسيطر على الحياة، ويجب أن يواكبها جيل اليوم بالدراسة والتعليم. والاستعمار تحول من استعمار عسكري إلى استعمار ناعم، وهو ما يشجع على الهجرة بكل الطرق من أجل عيش تلك الحياة التي يشاهدونها عبر الشاشات والعالم الافتراضي، رغم صعوبتها على أرض الواقع.
فالهجرة المكثفة للشباب نحو الضفة الأخرى، جعلت البعض يظن أن هؤلاء يريدون مغامرة الجزائر لأنهم لا يحبونها، لكن الحقيقة أن كل هؤلاء الموجودين بالخارج لأي سبب كان، سيقدمون كل ما يملكون فور تأكدهم من أن الجزائر تحتاجهم، فشباب اليوم واع جدا بما فعل الاستعمار في أجدادهم، وكيف استغل الاستعمار ثروات الجزائر لبناء بلده واستغل جهود الجزائريين وغيرها من المهاجرين، للنهوض بمختلف القطاعات واستمراره إلى اليوم في البحث عن كل السبل التي تمكنه من مواصلة استنزاف خيراتها المادية والفكرية.
وبالمناسبة، أشير إلى ملحمة “أم درمان” الكروية التي حدثت في السنوات الأخيرة، حيث تحول كل الشباب الجزائري إلى حديث العالم، بعدما شكلت الطائرات العسكرية الجزائرية جسرا جويا تنقل من خلاله الشباب الجزائري إلى السودان لمؤازرة المنتخب الوطني الجزائري ضد غريمه المصري آنذاك، ليس لعشقه كرة القدم، بل لأن المنتخب يمثل الجزائر، وهؤلاء لا يقنعهم بالإقبال على شيء إلا اسم الجزائر ونشيدها المقدس. هذه الواقعة أفضل وأصدق مثال عن وطنية الشباب الجزائري الذي يمكنني أن يعبر عن غضبه وتذمره لكن عندما يتعلق الأمر بوحدة التراب الجزائري وسلامة شعبها، فإنه لا يعرف للحياة معنى.
ما هي نصيحتكم للجيل الجديد؟
بعدما أمضيت 84 سنة، عاصرت خلالها 3 أجيال، فأنا مقتنع ومؤمن أن الجزائر المسقية بدماء الشهداء لا تزال بين أيادي آمنة ولا خوف عليها في ظل توحد أبنائها.
وفي صلب النصيحة، أركز على ضرورة العمل على غرس ثقافة البناء والتشييد عن طريق العلم والاهتمام بمواكبة العصرنة لأن حروب اليوم تعتمد على العلم والغزو الفكري الناعم، وهذا ما يجب أن يستوعبه أبناءنا، إلى جانب التكفل الصحيح بهم من طرف مختلف المؤسسات والهيئات، فالعلم أساس النجاح والتقدم.
وأخيرا، بعد هذه المسيرة الحافلة، هل حصلتم على كل ما كنتم تحلمون به؟
الحمد والشكر لله أولا على الصحة ونعمة الأمن لجزائرنا، وما وصلت إليه من رقي بفضل سواعد رجالها الصادقين. أما على الصعيد الشخصي، فأنا محاط بأحبائي وعائلتي التي تضم زوجة ثانية بعد رحيل الأولى أم أولادي الخمسة (5)، الذين أسعدوني بـ 16 حفيدا أمضي معهم جل أوقاتي، بينما أنتظر فقط الحصول على رخصة البناء من أجل استكمال مشروع سياحي صغير بمسرغين، بعدما تم تحويل المنطقة من فلاحية إلى عمرانية، حيث سيكون إضافة مهمة للمنطقة، خاصة وأنها مقصد الكثير من الزوار الباحثين عن الهدوء والسكينة.
حاورته: ميمي قلان