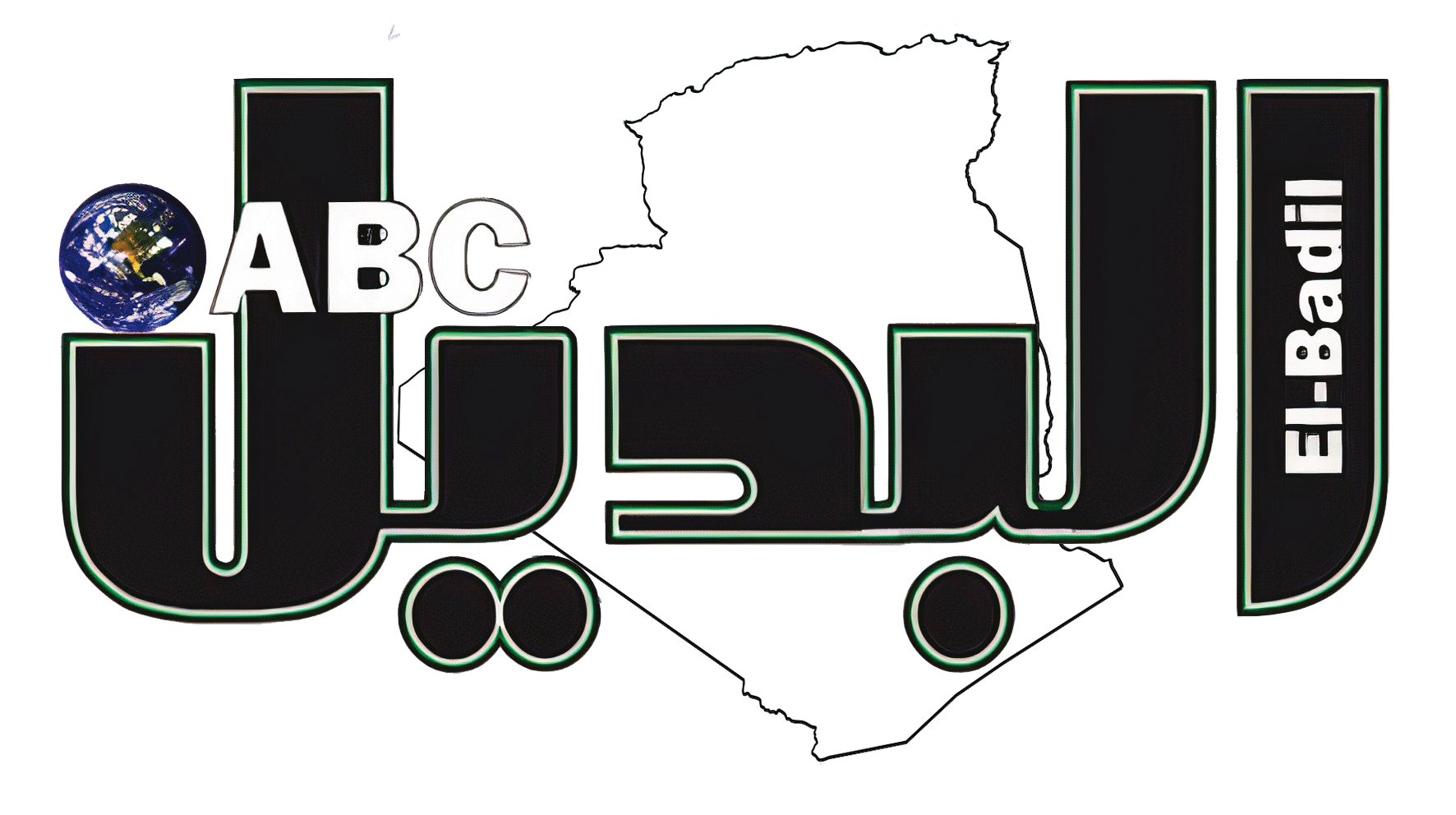في العقود السابقة، كانت غرف الأخبار تموج بالحركة البشرية: صحفيون يهرولون لتأكيد معلومة، محررون يراجعون النصوص، ومدير تحرير يضبط العناوين ويقرر ما يستحق النشر. اليوم وفي البلدان التي تتمتع بتطور تكنولوجي رهيب تغيّر المشهد جذريًا.
ظهرت “غرف الأخبار الذكية” كوجه جديد للمؤسسات الإعلامية، تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الآني للبيانات. لكن، خلف هذه “الحداثة التقنية”، يختبئ جدل واسع حول دور الإنسان في تشكيل الحقيقة، وحدود الثقة في الخوارزميات التي تتحول تدريجيًا إلى محرر رقمي لا يُناقش.
الغرفة الذكية
تعتمد غرف الأخبار الذكية على شبكة من البرمجيات والخوارزميات التي تتابع الأحداث من مصادر متعددة في الزمن الحقيقي، ثم تُحللها وترتبها وفق معايير محددة سلفًا: الأهمية، التفاعل، الجغرافيا ودرجة الجدة. بعض الأنظمة قادرة حتى على توليد تقارير جاهزة للنشر في دقائق.
الفكرة في ظاهرها مغرية: سرعة، كفاءة وتركيز أكبر على القضايا “الرائجة”، إلا أن هذا التوجه يحمل في طياته انقلابًا هادئًا على القواعد التحريرية الكلاسيكية. من الذي يقرر أن خبرًا ما “يستحق النشر”؟ هل هي التجربة الصحفية أم معادلة رياضية جافة؟
من الإبداع إلى التلقين
بينما توصف الغرف الذكية بأنها تُحرر الصحفي من المهام الروتينية، إلا أن الواقع الميداني يكشف تحوّلاً في طبيعة العمل الصحفي نفسه. كثير من الصحفيين يجدون أنفسهم أسرى لواجهات إلكترونية، تُطلب منهم إدخال نصوص وفق قوالب مسبقة، أو تحرير محتوى أنتجته الخوارزمية لا غير.
بهذا الشكل، يدفع الصحفي تدريجيًا نحو دور تقني، أقرب إلى “مراقب جودة” لما تنتجه المنظومة. وهذا يضعف الحضور الإنساني في انتقاء الزوايا، وصياغة الأسئلة، والتحقيق في خلفيات الأحداث. فهل نريد صحافة سريعة أم صحافة واعية؟
التحيّز الخفي
المشكلة ليست في وجود الذكاء الاصطناعي داخل غرفة الأخبار، بل في غياب الشفافية حول طريقة اتخاذ القرار التحريري. فالخوارزميات مصممة من قبل البشر، وتغذى ببيانات تحمل في طياتها تحيّزات ثقافية، سياسية، وحتى تجارية.
إذا كانت المنصة تفضل الأخبار التي تحصد تفاعلًا أكثر، فإن المواضيع المثيرة أو المثيرة للجدل ستحظى بظهور أكبر، ولو على حساب التوازن والموضوعية. وهذا يعيد إنتاج خطاب إعلامي موجه بحسب أهواء الخوارزمية، وليس بالضرورة بحسب مصلحة الجمهور أو حاجاته المعرفية.
عندما يقرأ القارئ خبرًا منشورًا في صحيفة معروفة، فهو يفترض ضمنًا أن فريقًا صحفيًا محترفًا تحقّق منه، وحرره، وراجعه قبل نشره. لكن في غرف الأخبار الذكية، قد تكون القصة من إنتاج خوارزمية بالكامل، دون تدخل بشري فعلي.
هذا يطرح سؤالًا جوهريًا حول الثقة. إذا تساوى الخبر الجيد والرديء في سرعة النشر، وإذا لم يعد معروفًا من صاغ المعلومة، فكيف يمكن للقارئ أن يميز الحقيقة عن التلاعب؟ هل نسلم ذاكرتنا الجماعية لآلة لا تحاسب؟
التكلفة الإنسانية
بموازاة الثورة التقنية، تشهد المؤسسات الإعلامية تحولات بنيوية تؤدي إلى تقليص عدد الصحفيين والمحررين، بدعوى الكفاءة والسرعة. بعض المؤسسات العالمية استغنت عن فرق كاملة من المحررين لصالح أنظمة تحرير مؤتمتة.
هذا التوجه لا يعني فقط خسارة وظائف، بل تآكلًا في الخبرات والمخزون المهني الذي يراكمه الصحفيون عبر السنين. فهل يمكن تعويض الحس التحريري، والقراءة بين السطور، والتأمل النقدي، بمعادلات منطقية مهما بدت ذكية؟
ليست كل غرف الأخبار قادرة على التحول نحو الذكاء الاصطناعي بنفس السرعة أو القدرة. المؤسسات الكبرى، المدعومة ماليًا وتقنيًا، تستطيع امتلاك أنظمة تحليل متقدمة وتوظيف خبراء في علوم البيانات، أما الصحف المحلية والمستقلة، فتجد نفسها في مواجهة غير متكافئة.
هذا التفاوت يهدد بتعميق الفجوة الإعلامية، ويجعل السيطرة على السرديات الإخبارية في أيدي من يملكون التقنية، لا من يملكون القرب من الواقع. كما يضعف التنوع في الطرح، ويهمش الأصوات البديلة.
لا يمكن العودة إلى الوراء، ولا تجاهل إمكانات الغرف الذكية. لكن المطلوب ليس تبنّي التقنية بشكل أعمى، بل مساءلتها، وتطويعها لخدمة الإنسان لا استبعاده. على المؤسسات الإعلامية أن تحتفظ بمحررين بشريين يشرفون على عمل الخوارزميات، ويراجعون إنتاجها، ويعدّلون مسارها متى لزم الأمر
كما ينبغي إشراك الصحفيين في تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي، لتكون هذه الأنظمة امتدادًا لعقلية تحريرية واعية، لا بديلًا عنها. فالمشكلة ليست في الآلة، بل فيمن يبرمجها، وفي الأهداف التي تسخّر لها.
في نهاية المطاف، لا تقاس ذكاء غرفة الأخبار بعدد الأخبار المنشورة، ولا بسرعة التحديثات، بل بقدرتها على طرح الأسئلة الأصعب، ومساءلة من في السلطة، والوقوف إلى جانب الحقيقة ولو ضد التيار. إذا فقدت الغرفة هذه الروح، فإن الذكاء يصبح عبئًا، والتقنية تصبح قيدًا يجمّل الاستسلام.