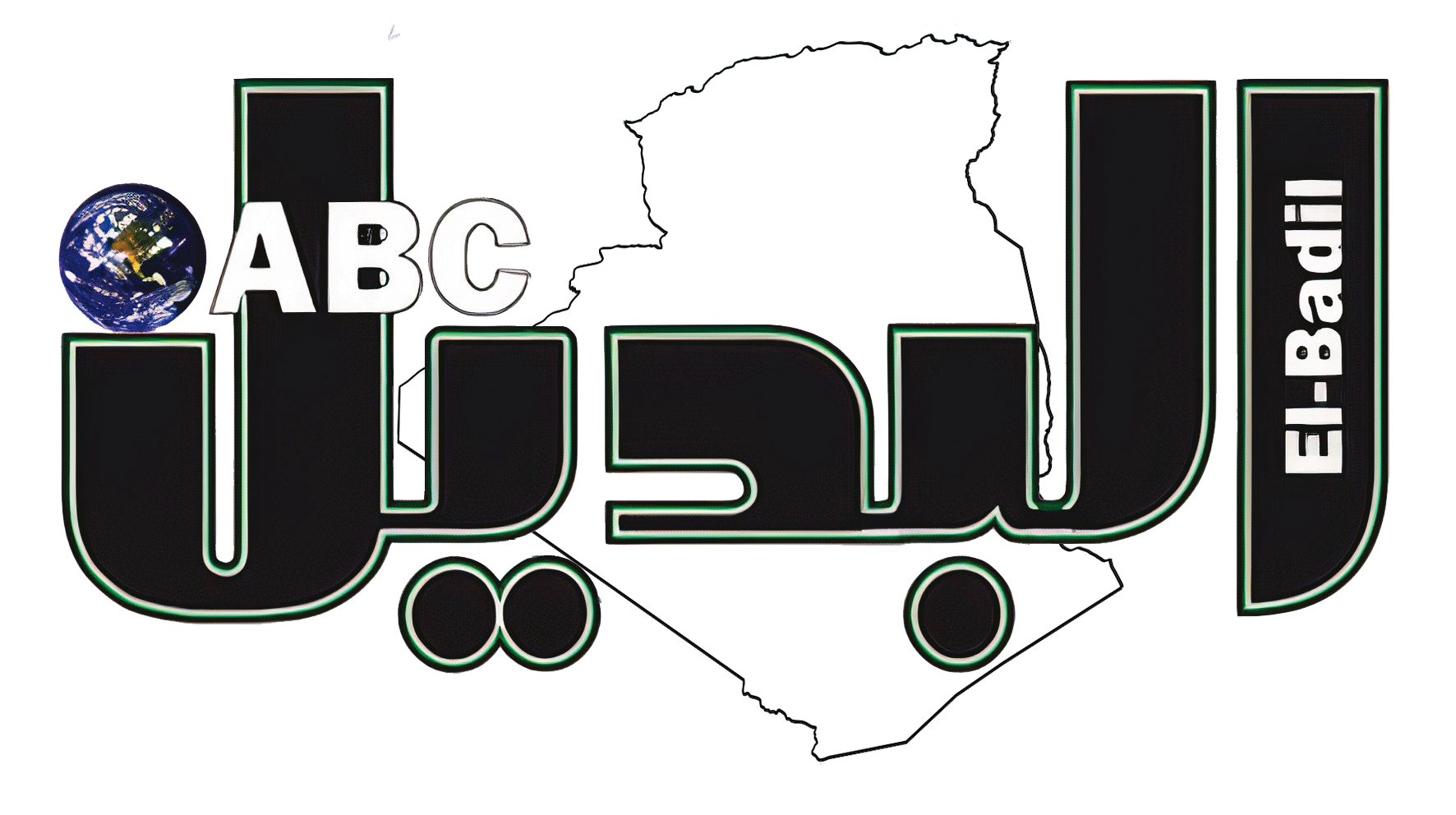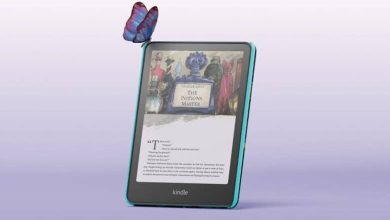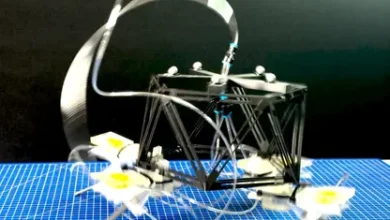شهدت مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة بفعل دخول الذكاء الاصطناعي إلى البيئة الجامعية، فقد أصبح حضور هذه التقنية ملموسا في طرق التدريس وآليات التقييم وأسلوب إعداد المهام الأكاديمية، إلا أن هذا الحضور لا يطرح بالضرورة إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الجامعات أصبحت أفضل بفضله، بل يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول طبيعة هذا التحول واتجاهاته وتبعاته على المدى الطويل، خاصة في ظل اختلاف وجهات النظر بين الطلاب والمعلمين وبين المهتمين بتطوير التعليم ومراقبي جودة مخرجاته.
اعتمدت الجامعات في البداية على الذكاء الاصطناعي بشكل جزئي كمساعد في عمليات إدارية بسيطة، لكنها سرعان ما توسعت في استخدامه ليشمل أنظمة الدعم الأكاديمي وأدوات التقييم والبحث، مما منح الطلبة إمكانية الوصول إلى موارد متنوعة ووسائل مساعدة ذكية تحلل النصوص وتقترح الأفكار وتنظم المقالات، وهو ما مكّن فئات كبيرة من الطلاب من تحسين أدائهم الدراسي والتغلب على صعوبات اللغة والتحليل، لكنه في الوقت نفسه خلق مخاوف من الاعتماد الزائد على التقنية وفقدان القدرة على إنتاج المعرفة بجهد ذاتي، إذ يرى بعض الأساتذة أن هذه الأدوات تقدم حلولًا سريعة لكنها قد تعيق نمو المهارات الحقيقية المطلوبة في بيئة العمل.
من جهة أخرى، بدأت الجامعات نفسها تواجه تحديًا جديدًا يتمثل في القدرة على التمييز بين العمل البشري والعمل الناتج عن الآلات، حيث أصبحت بعض المهام المكتوبة تظهر بمستوى عالٍ من الصياغة والتناسق، ما جعل من الصعب تقييم الأداء الفعلي للطالب، فالتقنية هنا ليست مجرد أداة بل أصبحت طرفا مؤثرا في علاقة الطالب بالمعرفة، وهذا يفرض على الجامعات إعادة النظر في معايير التقييم التقليدية، بما يتلاءم مع بيئة تعليمية باتت تشهد حضورا دائما للذكاء الاصطناعي في قاعات الدراسة والبحث.
دعم أكاديمي أم اختصار للمسار؟
من أبرز آثار استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي هو تسهيل إنجاز المهام الدراسية بشكل أسرع، فبدلا من قضاء أيام في البحث عن فكرة لمقال جامعي أو تنظيم محتوى مشروع تخرج، أصبح بإمكان الطالب الحصول على مقترحات فورية ومخططات جاهزة، بل وحتى توليد فقرات تحليلية خلال دقائق، وهذا قد يبدو دعما مهما في بيئة تعليمية تتسم بضغوط متزايدة، إلا أن هذا التيسير يحمل في طياته تساؤلات جوهرية حول نوعية الجهد المبذول والمعرفة المتحصلة.
يرى بعض المتخصصين أن الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي قد يشبه الاستعانة بمدرس خاص أو مرشد علمي، حيث لا يكون الهدف هو تسليم العمل جاهزا، بل الاستفادة من التوجيهات لتطوير فهم أعمق للموضوع، غير أن الواقع يُظهر أن كثيرا من الطلاب يلجؤون إلى هذه الأدوات كوسيلة اختصار للوقت وليس كوسيلة دعم معرفي، وهذا ما يثير القلق حول التحول من التعليم القائم على الاستيعاب إلى التعلم القائم على الإنجاز السريع، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على مستوى التفكير النقدي والقدرة على التعبير الذاتي.
وفي هذا السياق، بدأت بعض الجامعات بتنظيم ندوات توعوية للطلبة حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كما لجأت إلى تحديث سياساتها الأكاديمية لتشمل بنودا واضحة حول متى وكيف يمكن استخدام هذه الأدوات، وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين الاستفادة من التطور التقني والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، كما شجعت المؤسسات التعليمية على دمج محاور الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج الدراسية لتأهيل الطلبة لاستخدامه بطريقة مسؤولة.
تغيير في المهارات المطلوبة ومعايير المستقبل
أدى دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي إلى تغييرات تدريجية في نوعية المهارات التي يتوقع أن يمتلكها الخريجون، فالمعرفة النظرية لم تعد كافية وحدها، بل أصبح مطلوبا من الطالب الجامعي أن يكون قادرا على استخدام الأدوات الذكية بفعالية، مع القدرة على التحليل النقدي للنتائج التي تقدمها، وهذا ما يضع على عاتق الجامعات مسؤولية تحديث مناهجها بما يتماشى مع واقع سوق العمل، الذي بات يعتبر الكفاءة في التعامل مع التقنيات الرقمية من الشروط الأساسية للتوظيف في عدد متزايد من القطاعات.
من جهة أخرى، أثارت هذه التغيرات مخاوف لدى بعض الطلاب الذين يخشون أن تؤدي زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى تهديد فرصهم في المستقبل، خصوصا في التخصصات التي تعتمد على التكرار أو المهام القابلة للأتمتة، وهو ما أكدته نتائج بعض الدراسات التي أشارت إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الطلبة في بعض الدول المتقدمة يشعرون بالقلق من أن التكنولوجيا قد تحل محلهم في سوق العمل، ومع ذلك فإن هذا القلق لم يمنعهم من مواصلة استخدام هذه الأدوات بل دفعهم إلى محاولة فهمها والتكيف معها.
وتشير تجارب العديد من الجامعات إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة تقليص دور الإنسان، بل يمكن أن يؤدي إلى إعادة توزيع الأدوار وتوجيه الجهد البشري نحو مهام أكثر إبداعًا وتحليلًا، وقد تكون أهم فائدة تحققها هذه التقنية في الجامعات هي إتاحة فرصة لإعادة تعريف مفهوم التعلم، ليصبح أكثر مرونة وتكيفًا مع احتياجات العصر بدلًا من التمسك بنموذج تقليدي لم يعد كافيًا لمواجهة تحديات المستقبل.