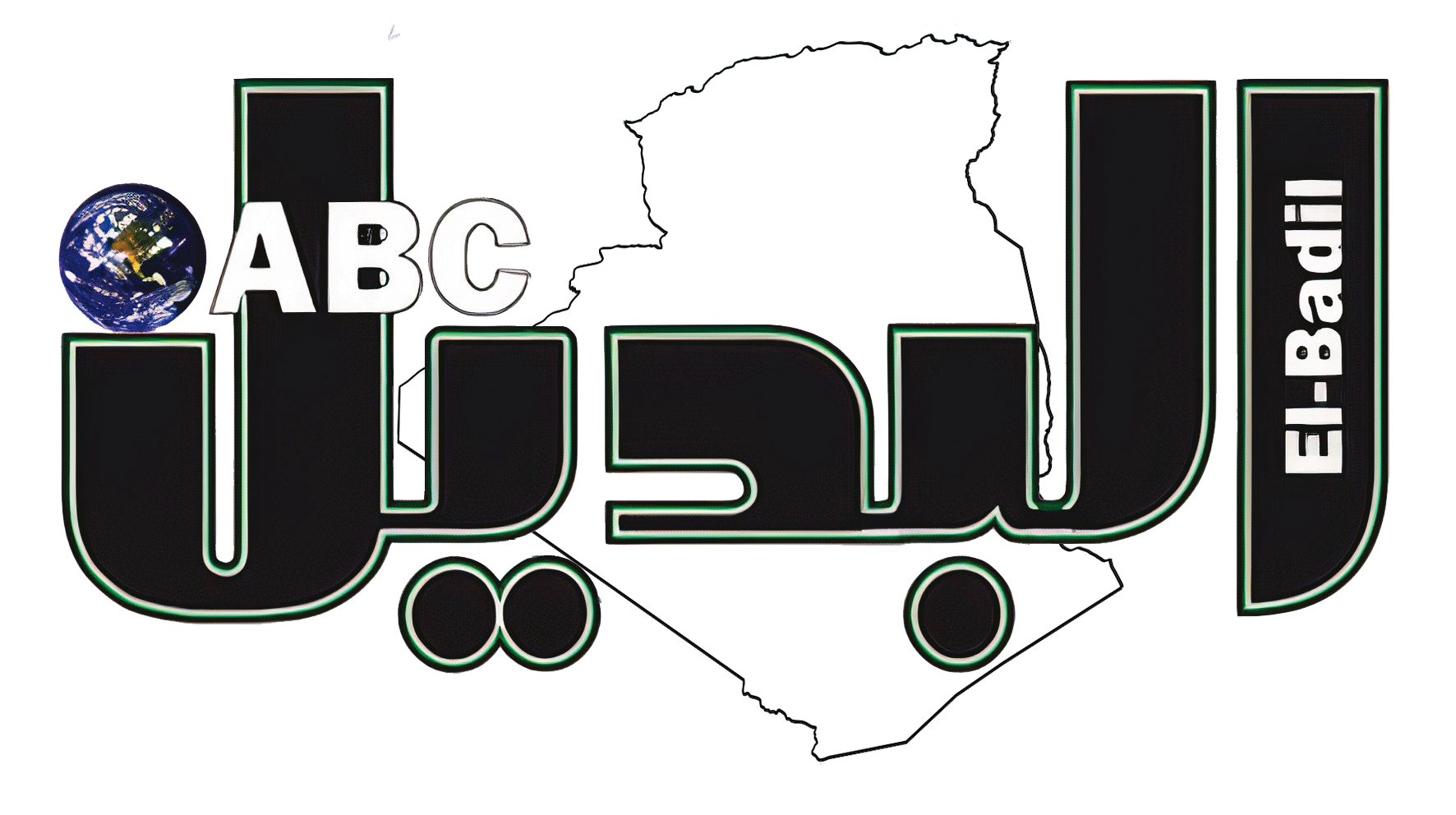في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، تحوّل التقييم الرقمي إلى أداة مركزية في مختلف مناحي الحياة، من التعليم والتوظيف، إلى التسوّق والترفيه. لم يعد التقييم محصورا في المدارس أو الشركات، بل أصبح ظاهرة شاملة تقيم البشر، المنتجات، الخدمات، وحتى الأفكار عبر أنظمة خوارزمية تعتمد على جمع وتحليل البيانات الرقمية.
وبينما يُنظر إلى هذه الأنظمة كوسيلة لتحسين الكفاءة وتحقيق الموضوعية، تتعالى أصوات متزايدة تحذّر من مخاطرها، خصوصًا ما يتعلق بالانحيازات الخفية، التلاعب، وغياب المعايير الأخلاقية.
من الورق إلى الشاشة
عرف البشر منذ القدم أنظمة للتقييم، من الامتحانات التقليدية إلى تقارير الأداء المهني، وكانت تلك الأساليب تتم في الغالب من خلال التفاعل المباشر بين المقيم والمقيَّم. لكن التحوّل الرقمي، خاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي، غيّر هذه المعادلة. حيث أصبحت الأنظمة الرقمية هي التي تقيّم الأفراد تلقائيًا بناء على بيانات رقمية تُجمع عبر وسائل مختلفة، كالنقرات، المشاهدات، التفاعلات، وحتى تعبيرات الوجه.
هذا التحول أفرز ما يُعرف اليوم بـ”اقتصاد السمعة الرقمية”، حيث يمكن لتقييم رقمي بسيط أن يؤثر على فرص الشخص في العمل، القبول الجامعي، أو حتى إمكانية حصوله على قرض مالي.
التعليم تحت المجهر الرقمي
من أبرز المجالات التي شهدت تطبيقًا واسعًا للتقييم الرقمي هو قطاع التعليم، حيث أصبحت المنصات التعليمية تعتمد على خوارزميات لتتبع أداء الطلبة وتصنيفهم. هذه الأنظمة تقوم بتحليل نسب المشاركة، الأجوبة، مدة المشاهدة، وعدد المحاولات في الاختبارات، لتوليد تقييم يُفترض أنه موضوعي وعادل.
غير أن هذه الأنظمة لا تأخذ في الحسبان العوامل النفسية والاجتماعية التي قد تؤثر على أداء الطالب. كما أنها قد تُقصي طلابا لديهم مهارات لا يمكن قياسها رقميا، مثل الإبداع، التفكير النقدي، أو التواصل الإنساني. في هذا السياق، يُطرح سؤال مشروع: هل يمكن اختزال ذكاء الإنسان وإمكاناته في أرقام ورسوم بيانية؟
الوظائف والمقابلات المؤتمتة
في ميدان التوظيف، تبنّت العديد من الشركات الكبرى أنظمة تقييم رقمية لتصفية المتقدمين للعمل، من خلال خوارزميات تقوم بتحليل السير الذاتية تلقائيًا، أو مقابلات فيديو ترصد تعابير الوجه ونبرة الصوت. تهدف هذه الأساليب إلى تسريع عملية الاختيار وتقليل التحيز البشري، لكنها في المقابل تُتهم بتكريس نوع جديد من الانحياز، هذه المرة انحياز رقمي ناتج عن طبيعة البيانات المُدرّبة عليها الخوارزميات.
فمثلًا، قد تُقصى مرشحة مؤهلة فقط لأنها لم تستعمل كلمات مفتاحية “مطلوبة” ولأن الكاميرا التقطت “تعبيرا” غير مقنع أثناء المقابلة. وهنا تتحول الخوارزمية من أداة تقييم إلى حكم لا يُراجع. مما يفتح الباب أمام حالات تمييز صامت يصعب كشفه أو الطعن فيه.
حين يصبح الإنسان نفسه منتجا
مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، بات الأفراد أنفسهم يُقيّمون باستمرار عبر الإعجابات، التعليقات والمشاركات. هذا النوع من التقييم يولّد شعورًا دائمًا بالمراقبة، ويدفع الكثيرين لتعديل سلوكهم بما يُرضي الخوارزمية ويزيد من ظهورهم، حتى لو كان ذلك على حساب الأصالة أو السلامة النفسية.
والمثير للقلق أن هذه المنصات تقوم ببناء “نماذج شخصية” عن المستخدمين، تُستعمل لاحقًا في عرض الإعلانات أو حتى توجيه المحتوى السياسي. وهكذا، يتحول التقييم من أداة للقياس إلى وسيلة للسيطرة والتوجيه.
التقييم المالي والائتماني
يُستخدم التقييم الرقمي أيضا في القطاع المالي، حيث تحدد الشركات درجة الجدارة الائتمانية للمستهلكين بناءً على بيانات رقمية تشمل تاريخ الشراء، أنماط الدفع، وحتى سلوك التصفح. في الصين، على سبيل المثال، طوّرت الدولة نظام “الائتمان الاجتماعي” الذي يُقيّم المواطنين بحسب ولائهم للنظام، سلوكهم في الأماكن العامة، وحتى صداقاتهم الرقمية.
مثل هذه النماذج تُثير تساؤلات أخلاقية عميقة، لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس رقمية بالكامل، وتفتح المجال أمام مجتمعات تُراقَب وتُعاقَب رقميًا دون محاكمة أو فرصة حقيقية للطعن في القرار.
هل العدالة الرقمية ممكنة؟
يرى بعض الباحثين أن التقييم الرقمي لا بد أن يخضع لمعايير شفافة وقابلة للتدقيق. يجب أن تُصمَّم الخوارزميات من قِبل لجان متعددة التخصصات، تشمل خبراء في التقنية، القانون، الأخلاق وعلم النفس. كما يجب أن يُمنح المستخدمون الحق في معرفة كيف تم تقييمهم، ولماذا، ومن قِبل مَن، إضافة إلى الحق في الاعتراض والمراجعة.
غير أن هذا الطرح يصطدم بعقبات قانونية وتجارية، إذ إن كثيرًا من الشركات تعتبر خوارزمياتها “أسرارًا تجارية”، وترفض الإفصاح عنها حتى للجهات التنظيمية، مما يعمّق الفجوة بين الشفافية والربح.
الخطر الصامت
العديد من الدراسات أثبتت أن الخوارزميات ليست محايدة، بل تعكس القيم والانحيازات الموجودة في البيانات التي تم تدريبها عليها. فإذا كانت تلك البيانات تحمل تمييزًا عرقيًا أو جنسيًا، فإن التقييم الرقمي سيكرّس هذا التمييز دون وعي. وفي هذا السياق، يُصبح “التحيّز الرقمي” أخطر من التحيّز البشري، لأنه يُقدَّم بواجهة من الحياد الزائف.
بين الأمل والقلق
لا يمكن إنكار أن التقييم الرقمي قد ساهم في تحسين الكفاءة والسرعة في كثير من المجالات، كما أتاح فرصًا للتحليل الدقيق والتنبؤات المستقبلية. إلا أن الاعتماد المفرط عليه قد يؤدي إلى اختزال الإنسان إلى مجرد رقم، وتجاهل الجوانب الإنسانية العميقة التي لا يمكن تمثيلها بلغة الآلة.
لذلك، يحتاج العالم إلى صياغة “ميثاق رقمي عالمي” يوازن بين التقدم التكنولوجي وحقوق الإنسان، يضمن الشفافية، ويُخضع الخوارزميات للمحاسبة القانونية والأخلاقية.
نحو تقييم رقمي إنساني
في النهاية، لا يكمن الخطر في التكنولوجيا ذاتها، بل في كيفية استخدامها. فالتقييم الرقمي يمكن أن يكون أداة قوية لتحقيق العدالة والكفاءة، لكنه قد يتحول في غياب الرقابة إلى سلاح يُقصي ويهمّش. وبين خوارزميات تُقيّمنا دون أن نراها، وقرارات تُتخذ بناء على بيانات لا نفهمها. يبقى الإنسان هو الحلقة الأضعف، ما لم يطالب بحقه في الشفافية، الكرامة، والاختيار.