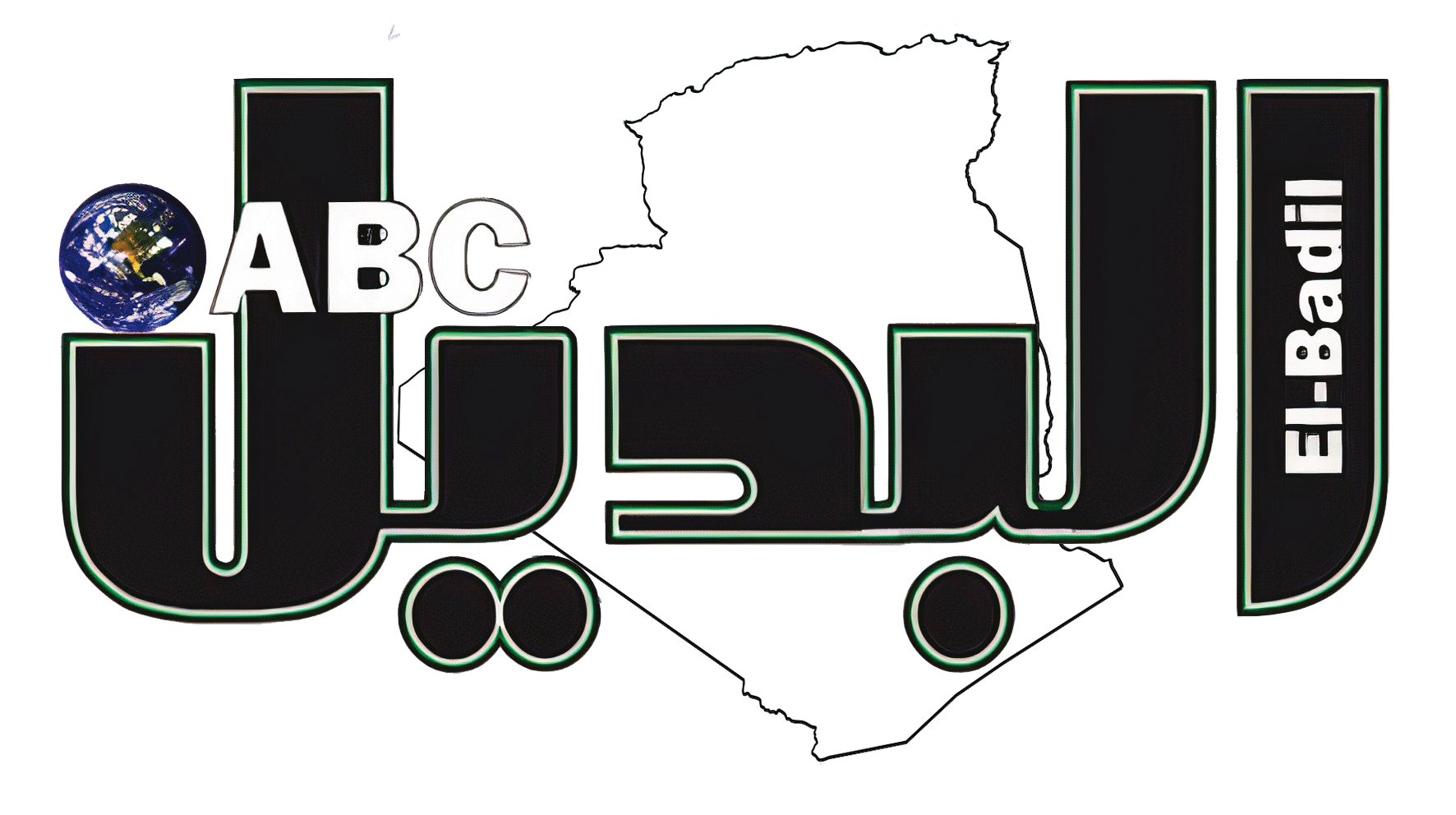لازالت عاصمة الزيانيين تفتخر بأعـز معلم تاريخي ديني في أيام المحن، أيام كانت الجزائر محتلة تحت ضغط استعمار غاشم لا تعرف من جنوده إلا الوحشية وطمس الشخصية، لكن سرعان ما وقف رجال صادقوا ما عاهـدوا الله عليه، فقاموا ببناء هذا الضريح العلمي الديني الذي تعاقب عليه أجيال هذه الجامعة الموحدة التي أسست مختلف علوم الدين من فقه وسيرة وسنن نبوية، إلى جانب التاريخ الثوري الشامل والتربية، فأراد مؤسسها إلى أن تكون مكانا واعدا للحديث والكلام على حسب ميولاته، سواء عملية أو ثقافية، حيث لم يتمكن الاستعمار من زعزعة ما تركه الأولون من لبّ ثقافي وأثري.
هذا الرمز التاريخي هو “دار الحديث”، الواقعة وسط مدينة تلمسان والتي أصبح ذكرى الـ 88 لـتأسيسها في تنامي هذه المؤسسة العلمية الدينية،التي توارثها التلمسانيون من عـلماء، كان هدفهم الوحيد هو التشييد العلمي والإفصاح عن صورتها بشكل واسع.
أثناء المؤتمر السنوي العام لجمعية العلماء المسلمين المنعـقـد بالعاصمة في سنة 1937 الموافق لـ 1356 هـ، الذي حضره أكثر من 5 آلاف من أعضاء الجمعية وأنصارها، والذي خاطبهم السيد البشير الإبراهيمي بحديث عذب وقيم قائلا فيه: “إن لي أمانة أودّ أقدمها إلى أهلها وهي أن إخوانكم التلمسانيين يسلمون عليكم ويتمنون أن يكون فتح هذا المعلم الديني على يد العلامة الشيخ “عبد الحميد بن باديس” زعيم النهضة ورئيس الجمعية”.
للعلم، أن “دار الحديث” سميت على “دار الحديث الأشرفـية”، التي تعود منذ قرون بدمشق وتخرج منها علماء وأئمة خدموا الإسلام والبلاد،وكان الشيخ “البشير الإبراهيمي” من خريجيها، ولهذا أراد أن يكون بتلمسان منشأ بها، ومن هذا المؤتمر تهيأ الجميع للسفر وهم يستعدون لتدشين دار الحديث الذي كان يوم الاثنين 22 رجب 1356 هـ الموافق لــ 29 سبتمبر 1937 م،وحل على تلمسان وفود من كل الجزائر ومن الدول المغاربية، ليكونوا على موعد تاريخي حالم لم تشهده من قبل.
وحينما جاء الوقت الحاسم للتدشين، رددالشيخان أثناء التدشين عبارات تدمع لها العين ويخشع لها القلب، فقد تقدم الشيخ “البشير الإبراهيمي” والأنظار،كلها متجهة صوبه، وهو يقف على عتبة الباب مخاطبا رئيس الجمعية وبيده المفتاح: “أخي الأستاذ الرئيس لو علمت في القطر الجزائري، بل في العالم الإسلامي رجلا له يد على العلم مثل يدكم وفضل على الناشئة على فضلكم، لأثرته دونكم بفتح هذه المدرسة، ولكن لم أجد باسم تلمسان والجمعية سواكم”، وناوله المفتاح وبعدها قال الشيخ “عبد الحميد بن باديس”: “بسم الله الرحمن الرحيم على اسم العروبة والعلم والفضيلة أفتح مدرسة دار الحديث، ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”،ثم قام بفتح الباب ودخل وكان خلفه العلماء والضيوف والمدعـوون وبقيت جموع غفيرة لم تتمكن من الدخول، ولكن طالوا رؤية الشيخ وسماعه قلبي طلهم وأطل عليهم من الشرفة رفقة العلماء قائلا: يا أبناء تلمسان كانت عليكم أمانة من تاريخنا فأديتموها فنعم الأمناء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم”، وبعدها دخل الحضور إلى قاعة المحاضرات، حيث قدمت هذه كلمات للعلماء الأجلاء إن الشهادات التي منحتها جمعية العلماء المسلمين لخريجي دار الحديث كدليل على قيمتها العلمية، وما نلمسه من الميدان من خلال هؤلاء الذين درسوا بها.
وحسب إحصائيات جريدة “البصائر” في عددها 202 الصادرة في 10 محرم 1372 الموافق لـ 24 سبتمبر 1952 ،أن عدد الناجحين بكل المدارس 123 ناجحا، أما الناجحون بدار الحديث في نفس السنة 35 ناجحا، وهذا ما يعني أنها مثلت ثلث من المجموع العالم على مستوى الوطن.
للتذكير، فإن المغاربة تأثّـروا بهذه القيمة الإبراهيمية وراحوا يؤسّسون معهدا إسلاميا، أطلقوا عليه “دار الحديث الحسنية” في مدينة الرباط، ولما عجّ عدد كبير من الطلبة ولم تعد تتسع الحجرات لهذا العدد الهائل من الطلبة، تعززت دار الحديث بمدينة ثانية ملاحقة لها سنة 1952.
للعلم، فإن عدد التلاميذ الذين سجّـلوا بها قبيل الثورة التحريرية 18000 طالبا، مقسمين إلى 4 أفواج بين النهار والمساء، الذين يزاولون الدراسة بالمدارس الفرنسية، كما عرفت دار الحديث إشعاعا علميا لمّا كانت تابعة لوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، وقد توقفت عن هذا المهام سنة 1972، أما اليوم فقد أصبح عملها قائما على استقبال 400 تلميذ سنويا بالمدرسة التحفيظية، وتدريس أحكام التلاوة للنساء وتقديم دروس لمحو الأمية لفائدة 100 امرأة إلى جانب شعائر تعبدية.
العلامة الإمام “عبد الحميد بن باديـس”يـزور مدينة مغـنية
لم تعرف مدينة مغنية ونواحيها ازدهارا ثقافيا بالمعنى المفهوم عن عبارة الحركة الثقافية، وذلك لصغرها وحداثة نشأتها والطابع الريفي الغالب عليها من جهة، ولقربها من تلمسان التي كانت تستقطب رجالات الفكر والثقافة، ولما يتوافر لهم بها من عوامل التشجيع، وروافد المعرفة من جهة ثانية، إلا أنه لم يمنع سكانالمنطقة من الإسهام الوافر في مجال الحفاظ على تراثهم الإسلامي وحفظشخصيتهمالعربية من الضياع والتمزق، ويرجع ذلك أساسا إلى الكتاتيب القرآنية المنتشرة في المدينة ونواحيها، والتي كانت تعج بالصبيان الذين رفض أولياؤهم بكل قوة أن يعلموهم لغة المستعمر، رغم وسائل الضغط التي لجأ إليها لفرض لغته على سكان الناحية.
وأهم هذه الكتاتيب والتي كان العامة يطلقون عليها اسم “الجوامع”، (جامع زوج بغال وجامع مغنية المدينة)، حيث كان لهذين الجامعين أهمية خاصة، حيث إن الدراسة فيهما لم تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم فقط، بل تجاوزته إلى فنون من المعارف الدينية واللغوية، وكان الطلبة يفدون إليها من القرى القريبة والنائية، رغبة في العلم والمعرفة، وكان نظام الدراسة في هذين الجامعين هو النظام التقليدي الذي يكاد يكون معروفا في كافة الأقطار العربية، فقد كان الطالب المبدئي بعد حفظه للقرآن الكريم يبدأ دراسته بالآجرومية في النحو، ومتن “ابن عاشر” في العقائد والفرائض، فإذا ما استوعبهما انتقل إلى دراسة القطر لـ “ابن هشام”، والرسالة لـ”أبي زيد القيروان”، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة الألفية ولامية الأفعال لـ “ابن مالك”، ومختصر خليل، وربما درس السيرة النبوية وشيئا من البلاغة والمنطق، وبذلك ينهي الطالب دراسته ويصبح الطالب مؤهلا لأن يطلق عليه اسم (العالم)، فمن الطلبة من يقف عند هذا الحد، ويعود إلى عشيرته فتتلقاه بالحفاوة والترحاب، وتقام له الحفلات، وينصب إماما لها وقاضيها ومفتيها، يلجا إليه السكان في قضايا دينهم، وفي الخصومات بينهم وعـقـد الزواج إلا في القليل النادر.
ومن الطلبة من كان يواصل مسيرة البحث عن المعرفة، فينتقل إلى أقرب مورد لها، وهو بالنسبة لهذه المنطقة أمتعة القرويين بفاس، أو ينتقل إلى جامعة الزيتونة بتونس، ومنهم من كان يشد الرحال إلى المشرق إلى جامع الأزهر الشريف.
لقد كان ذلك نوعا من الصمود في وجه المحاولات الاستعمارية الرامية إلى فصل هذه الأمة عن تراثها وأصالتها وعروبتها، تمهيدا لدمجها في كيانه الدخيل الغريب، وقد تخرج من الجامعين المذكورين عدد من الرجال واصلوا مسيرة الرفض والصمود في وجه محاولات المسخ والتشويه التي مارسها المستعمر منذ أن وطأت قدماه تراب هذه الأرض الطاهرة إلى أن طرد منها مدؤوما مدحورا.
وفي مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، زار مدينة مغنية المصلح الجزائري الكبير “الشيخ عبد الحميد بن باديس” وألقى بالمسجد الكبير خطابا شرح فيه دعوته الإصلاحية الرامية إلى تنقية الدين من الخرافات والبدع وتحريره من قبضة مشايخ الطرق وسيطرة الدراويش، وذلك بالرجوع إلى المصدرين الأساسيين لهذا الدين الكتاب والسنة.
ولم يتأت ذلك إلا بإنشاء مدارس لتعليم اللغة العربية على الطريقة الحديثة، واغـتنم الشيخ فرصة وجوده بالمدينة ففتح اشتراكا في جريدة “الشهاب” تسابق إلى الإسهام فيه أعـيان الناحية، وكان اشتراك الشهري لكل تلميذ يتراوح بين دينار ونصف إلى 3 دنانير، يعفى من أدائه الفقراء والمساجين السياسيين، بينما كانت أجرة الأستاذ تتراوح بين 25 دينار كحد أدنى إلى 250 كحد أقصى.
ومهما كان أثر هذه الزيارة، فإن ثمرتها المرجوة لم تبرز إلى الوجود إلا في نهاية العقد الرابع وبداية العقد الخامس من القرن الماضي، و في هاته الفترة أسست مدرسة التربية والتعليم تحت إشراف جمعية العلماء من التبرعات التي ساهم بها أنصار الجمعية بالناحية وحضر تدشينها المرحوم الشيخ “البشير الإبراهيمي” سنة 1952، وقد اشتملت مدرسة التربية والتعليم على (05) حجرات وبلغ عدد التلاميذ نحو (230) تلميذ بين ملازم وغير ملازم، بينما مدرسة التقدم اشتملت على نحو (350)تلميذ،وكانت هذه المدارس تتولى إلى جانب التعليم مهمة الوعظ والإرشاد وبث الوعي القومي الوطني بين أوساط السكان، لذلك سرعان ما أقفلها المستعمر في بداية حرب التحرير وألقى بمعظم أساتذتها في غياهب السجون، لتتحول مدرسة التربية والتعليم بعد الاستقلال إلى مدرسة تابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي، وأصبحت تحمل اسم “عبد الحميد بن باديس” وألحقت بها مدرسة التقدم إداريا.
لـقـد عاش الشيخ “عبد الحميد بن باديس” للفكرة والمبدأ ومات وهو يهتف (فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب)، لم يحد عن فكرته ومبدئه قيد أنملة حتى آخر رمق من حياته، ولم يبال بصحته الضعيفة التي تدهورت كثيرا في السنتين الأخيرة من حياته…هذا هو ابن باديس الذي عرفته الجزائر عالما عاملا، وفقيها مجتهدا، مربِّيا مخلصا، مصلحا، سياسيا وإماما كان يقضي بياض نهاره وسواد ليله في خدمة دينه ولغته وبلاده.
هذا هو الرجل الذي كان قلب الجزائر النابض، وروحها الوثابة وضميرها اليقظ، وفكرها المتبصر، ولسانها المبين، لم يضعف أمام هجمات الاستعمار المتتالية، ولم يستسلم لمناوراته وتهديداته، ولا للإغراءات والمساومات، بل بقي ثابتا على مبادئه صامدا حتى آخر حياته.
إعداد: ع. أمير