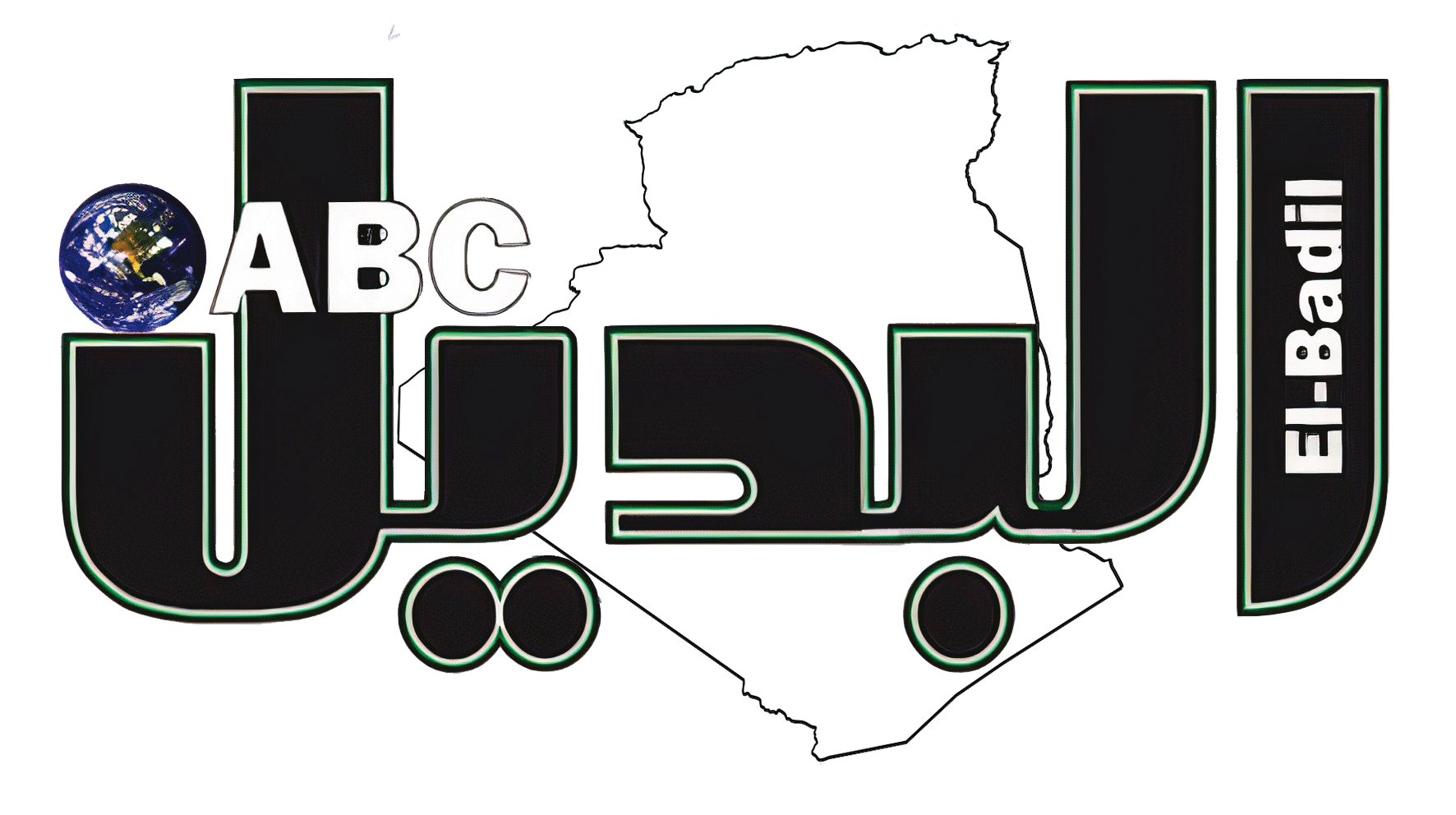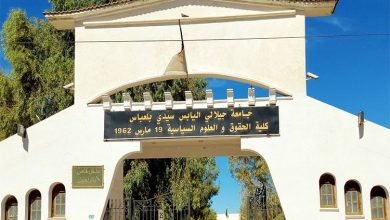لطالما شكل التعليم الركيزة الأساس في بناء الحضارات وصناعة الأمم. وفي السياق العربي والإسلامي، برز المفكر الجزائري مالك بن نبي (1905–1973) كأحد أبرز المنظرين لإصلاح منظومة التعليم من منظور حضاري شامل، لا يكتفي بتلقين المعارف وإنما يسعى إلى بناء الإنسان الفاعل في التاريخ، من خلال تفعيل دوره كعنصر مركزي في مشروع النهضة. ولأن التعليم كان في صلب إشكالية “القابلية للاستعمار” التي طرحها بن نبي، فإن تطويره لم يكن عنده مسألة تقنية أو إدارية، بل مسألة حضارية بامتياز تتصل بجوهر التحول المجتمعي.
أزمة التعليم: من التكديس إلى التلقين
يشير مالك بن نبي في كتابه “شروط النهضة” إلى أن “الجهل ليس فقط في عدم معرفة الحقائق، بل في عدم القدرة على ترتيب الحقائق لبناء فعل حضاري.” فمشكلة التعليم، كما يراها، لا تكمن فقط في قلة المعلومات أو ضعف المناهج، بل في طبيعة العلاقة التي تربط الطالب بالمعرفة: علاقة سلبية يهيمن عليها الحفظ والتكرار، بدل النقد والإبداع.
وقد انتقد بشدة ما أسماه “التكديس الثقافي”، أي جمع الشهادات والمعلومات دون القدرة على تحويلها إلى سلوك حضاري. فالمتعلم، في هذا السياق، يتحول إلى مجرد “حامل معلومات” دون أن يكون فاعلاً معرفياً أو صانعًا للتغيير. ومن هنا، فإن التعليم التلقيني في نظره ليس إلا مظهراً من مظاهر الانحطاط الحضاري.
التعليم كوسيلة للتمكين الحضاري
في فكر مالك بن نبي، لا يُنظر إلى التعليم باعتباره هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق “التحول من القابلية للاستعمار إلى القابلية للحضارة”. ولهذا، يربط التعليم بـ”رؤية حضارية” تؤطره ضمن مشروع شامل لإعادة بناء الإنسان المسلم. ويكتب في “مشكلة الثقافة” أن “الثقافة والتعليم ليسا تراكمين، بل بناءان وظيفيان في مشروع نهضوي متكامل”.
ويعني هذا أن تطوير التعليم يجب أن يُعيد تعريف “وظيفة المعرفة” داخل المجتمع، بحيث تصبح وسيلة لتحرير الإنسان من التبعية، وتمكينه من التفكير والعمل والإنتاج. وهنا يبرز مفهوم “التمكين الحضاري” بوصفه الهدف الأسمى لأي إصلاح تعليمي، والذي لا يمكن بلوغه إلا إذا تمت إعادة صياغة العلاقة بين الفكرة التربوية والواقع الاجتماعي.
مناهج التعليم وإعادة الاعتبار للفكر النقدي
واحدة من أهم إسهامات بن نبي تتمثل في إلحاحه على إعادة الاعتبار للفكر النقدي داخل المناهج التعليمية. لقد لاحظ أن طلاب المدارس والجامعات يفتقرون إلى “روح التساؤل”، وهي روح ضرورية لكل نهضة علمية. ومن ثم، يرى أن المناهج ينبغي ألا تقتصر على تقديم المعرفة، بل يجب أن تعلم الطالب كيف يفكر، لا ماذا يفكر.
وقد دافع عن ضرورة إحياء منهج الشك المنهجي الذي أسسه الغزالي والفارابي وابن رشد، والذي يسمح ببناء عقلية قادرة على التحليل والفهم بدل الاستهلاك والانبهار بالمعرفة الغربية. بهذا المعنى، فإن مشروع بن نبي يتقاطع مع مشاريع تربوية حديثة تدعو إلى ما يسمى بـ”التعلم النشط” و”التعلم القائم على المشاريع” و”التعلم مدى الحياة”، وهي كلها مفاهيم تصب في مبدأ تمركز المتعلم في العملية التعليمية.
دور المعلم: من ناقل إلى صانع وعي
لم يكن نقد بن نبي مقتصراً على المناهج، بل طال أيضا شخصية المعلم. فقد لاحظ أن كثيراً من المدرسين في العالم العربي يؤدون دور “الناقل” لا “الملهم”، أي أنهم ينقلون المعلومات دون أن يشكلوا نموذجاً يُحتذى به في السلوك والفكر. لهذا دعا إلى “تكوين الإنسان المعلم”، أي ذلك المثقف المندمج في بيئته، القادر على إشعال جذوة الوعي لا فقط إيصال المعلومات.
ويشبه بن نبي المعلم بالبذّار الذي يزرع الفكرة ويعتني بها حتى تنمو، ويشير إلى أهمية أن يكون “مربيًا للنفوس” قبل أن يكون موجهًا للعقول، وهو ما ينسجم مع التربية الإسلامية التي تؤكد على دور المعلم كقدوة.
التكنولوجيا والتعليم في مشروع التمكين
مع تسارع التحولات الرقمية، تزداد أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في تجديد التعليم، وهي فكرة تتماشى مع تصور بن نبي حول “تحرير الطاقات” الكامنة في الإنسان المسلم. فالتعليم الذكي، والتعلم المدمج، ومنصات المعرفة المفتوحة، تمثل اليوم أدوات يمكن توظيفها للانتقال من تعليم جامد إلى تعليم تفاعلي، ومن متعلم مستهلك إلى متعلم منتج.
ولئن لم يتعرض بن نبي مباشرة لموضوع التكنولوجيا، إلا أن فكره يسمح بتأويلات تؤكد انفتاحه على كل وسيلة من شأنها تحقيق الفاعلية الحضارية. المهم عنده ليس الوسيلة، بل الغاية: هل هي تحررية وتؤدي إلى التمكين؟ أم هي مجرد قشرة تجميلية تغطي عجزًا حضاريًا عميقًا؟
إصلاح الجامعة: بين الهوية والانفتاح
في فكر مالك بن نبي، لا تُختزل الجامعة في كونها مؤسسة أكاديمية لنقل المعرفة فقط، بل تُعد مؤسسة حضارية بالأساس، تشكّل عقل الأمة وتصوغ وعيها المستقبلي. وقد أشار بن نبي، في سياقات متعددة، إلى أزمة الجامعة في العالم الإسلامي، معتبرًا أن هذه المؤسسة وقعت في فخ التقليد والاستنساخ، وفقدت وظيفتها الحضارية الأصلية.
لذلك، فإن إصلاح الجامعة عنده لا يُفهم بوصفه تحديثًا تقنيًا أو شكليًا، بل مشروعًا تحويليًا عميقًا، يستهدف استعادة الدور الجوهري للجامعة كرافعة فكرية ومُحرك للتغيير الاجتماعي والاقتصادي. وهنا يربط بن نبي هذا الإصلاح بمبدأين متكاملين: الحفاظ على الهوية الحضارية، والانفتاح الواعي على المعرفة الكونية.
فلا يمكن لجامعة أن تنهض، إن كانت منقطعة عن ثقافة مجتمعها، ولا يمكنها أن تُسهم في إنتاج المعرفة، إن كانت منغلقة على نفسها ترفض الاستفادة من المنجزات العالمية. لذلك دعا إلى توازن حقيقي: تكون فيه الجامعة مُنتمية إلى جذورها، ومُنفتحة على عصرها في الوقت ذاته.
ويؤكد بن نبي أن الوظيفة الحقيقية للجامعة ليست فقط تخريج متعلمين، بل إنتاج “فاعلين حضاريين”، من خلال إعادة الاعتبار لوظائف الجامعة الثلاث: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع واقع الأمة واحتياجاتها التنموية.
ومن هذا المنطلق، يمكن تدعيم هذا التصور بأمثلة واقعية من التجربة الجزائرية، مثل جهود الرقمنة الجامعية، وتفعيل التعليم عن بُعد عبر منصات مثل “موودل”، وتجربة الجامعة الافتراضية الجزائرية، بالإضافة إلى سياسات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي التي بدأت تتبلور في السنوات الأخيرة.
كما يمكن الاستفادة من تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات مثل اليونسكو والبنك الدولي حول وضعية التعليم العالي في الجزائر، لربط الفكر النظري بواقع الممارسة، وتحويل رؤية بن نبي إلى خريطة طريق عملية لإصلاح الجامعات.
نحو تمكين معرفي لتحقيق خدمة المجتمع
إن فكر مالك بن نبي في التعليم ليس مجرد مراجعة نظرية، بل دعوة حقيقية لتأسيس مشروع حضاري شامل يقوم على تحرير العقل من القيود التقليدية، وتفعيل دوره الفاعل في صناعة الحضارة. التعليم، وفق رؤيته، يجب أن يتحول من مجرد تلقين إلى تمكين إنساني حقيقي يُمكّن للمتعلم أن ينتج، ويبتكر، ويصنع التغيير.
هذا الانتقال يمثل تغييرًا أساسيًا: من الكم المعرفي إلى النوع الحضاري، ومن التبعية الثقافية إلى الابتكار المحلي، ومن الانفعال إلى الفعل المؤثر. وإذا ما كان هدفنا هو إعادة بناء التعليم، والجامعة، والأجيال، فإن فكر مالك بن نبي يظل ملهمًا ومرشدًا، لإعادة وصل ما انقطع بين المعرفة والعمل، وبين الفكر والحضارة.
د. عمر العربي